هو قسم يتضمن مقالات سياسية تتحدث حول شأن الأوضاع السياسية فى مصر والعالم العربى بدءاً من أحداث ثورة 25 يناير " ثورة الصبار"
النخبة
اقرأ كتاباتهم واستمع إلى أحاديثهم تدرك أنهم توقفوا عن القراءة مذ بلغوا الحُلُم، تبصر بهائم ترعى في حقل الواقع رصدا وتحليلا واستشرافا وفعلا.. دون أن يشف ما يتغوطونه عن عمق أو فكرة بكر أو رؤية كلية، لكن لا أحد منهم في نبل الشاعر الإنجليزي كيتس وحياءه عندما أوصى صديقا له قبيل وفاته بأن ينقش على قبره: “هنا يرقد انسان كتب اسمه على الماء”، فالواحد منهم هو الكاتب الجليل، والمحلل القدير، والسياسي الكبير، والمفكر الألمعي!.
الوعي
ومازالت حالة ضعف بل انعدام الوعي مستشرية واضحة جلية تتحدى الوعي في صلف وغطرسة، ليصبح مشروعا أن نسأل: هل كانت الثورات ربيع شعوب أم خريف أنظمة؟!.
الفوضى
في زمن فوضوي اللون، خرج بولدير الأديب الفرنسي الشهير من منزله شاكيا سلاحه لحرب كانت تخوضها بلاده، دُهش من يعرفون أديبنا لهذه الخطوة غير المتوقعة، فقد كان شخصا لاه لا يعبأ لغير الأدب وعشيقته الراقصة السمراء، فسألوه عن السبب، ليجيبهم أن هذه الفوضى تتيح له فرصة لن تتكرر لقتل زوج أمه الجنرال أوبك..
وفي زمن فوضانا تتناثر الاتهامات في كل اتجاه، يطلقها كل أحد ضد كل أحد، بلا حسيب ولا رقيب، هذا إخوان وذاك خلايا نائمة أو طابور خامس….، وإذا تتبعتها إلى منابعها تجدها مكدرة بتصفية حسابات شخصية!!.
الأمن
قال لي أحد الناشطين السياسيين العرب الظرفاء: لست مع الوحدة العربية.. سألته لماذا؟! أجابني: لأن الواحد منا، ومازالت بلادنا رهينة للقبضة الأمنية، إن كان مطلوبا في بلدة سعودية صغيرة سُيجلب من قفاه من قهوة بوسط القاهرة، أو من حضن البتراء في الأردن، أو من أمام نافورة الجُفير بالبحرين!.
الإعلام
خطاب إعلامي يظل يكذب ثم يكذب حتى يصدق نفسه، معتمدا نظرية جوبلزية أنهى التاريخ صلاحيتها!.
الديمقراطية
تعوقها مديونيات مركبة، راكمناها على مدى زمني طويل عندما غفلنا، وتغافلنا، وضعفنا، وصمتنا، وجبنا، وسهلنا، وتساهلنا..، وحين نمت لدينا الرغبة في تسديد تلك المديونية كان علينا أن ندرك أنها لن تسدد دفعة واحدة، وأن بلدنا ليس صوبة نلقى بها بذرة الديمقراطية “المستوردة” لتنبت في الحال على غرار بيئتها الطبيعية، بل هو صراع مرير وزمن مديد لتكييف هذه البذرة مع تلك التربة!.
الثورة
مشروع أخلاقي بامتياز، إن يُداس تحت الأقدام لا يتبقى منها غير صراع على الدولة الغنيمة بين ساقطين، يسطرون بتدافعهم إلى السلطة سطرا إضافيا في مأساة شعبنا البائس.
التاريخ
يموج التاريخ البشري بنماذج لهزائم تسلل من ثناياها الانتصار كأبهى ما يكون، كذا يكشف عن معارك مرق أحد طرفيها من النصر مروق السهم من الرمية، لتحل به الهزيمة الماحقة، ومن هنا ولد مفهوم التراجيديا في التاريخ.. فما من هزيمة كاملة، وما من انتصار كامل، وعلينا أن ننتصب دوما في حذر!. لكن أولئك الذين قصدهم سانتيانا بقوله: “من لا يقرأون تاريخهم محكوم عليهم حتى القيامة بأن يكرروا أخطاء أسلافهم”، ليسوا معنيين بهذه الجدلية!.

الكاتب / محمد السيد الطناوى
قضيت أمس الأول الأربعاء أتابع أخبار فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وعصفت بي الحيرة بعدها، إذ لم أجد ما أشعر به، خواء يضم براحتيه عاطفتي في غير حنو، راقبتهم في صمت كما لو كانوا أشياءا غير حية، ولا غرابة فقد جرى الإعداد لتلك اللحظة بالوجدان في صمت، فأثمرت هذا الخواء عندما حانت. ألم أردد ـ صادقا ـ مرارا وتكرارا أن هؤلاء لا يؤمنون بالوطن، فلا وجود لهذه اللفظة في أدبياتهم، التي لا تحتفي بغير الأمة…؟، وأنهم من أجل تشكيل المجتمع الإسلامي كما ينبغي أن يكون، أو كما هو كائن في نموذجه المصغر “الجماعة”، لن يتحرجوا من استباحة هذا “المجتمع الجاهلي”، وأن سلطانهم كان “نكسة للثورة كتلك التي حطت على ثورات كثيرة عبر التاريخ.. وأنهم “يعاقبة” ثورتنا، وأن بركان أحقادهم الحي لمرشح للفوران لتندفع من فوهته حمم الدماء أكثر فأكثر!”.. ألم أدعو الجيش بلا مواربة لأن يكون أداة التغيير، في ظل عجز النخبة وفشلها المتواتر، ذاهبا إلى أن “مؤسسة الجيش لن تكون قادرة على الاحتفاظ بكينونتها كمؤسسة وطنية إذا تطاول حكم الإخوان” *، ورغم علمي حينها بما تستتبعه دعوتي هذه من تبعات، لكنني كنت وغيري، ندرك جيدا أن مخطط الجماعة في التمكين سيكون مآله انهيار الدولة، وان أي بديل مهما بلغت درجة سوءه سيكون أفضل من هذا المصير. كل هذا (وغيره من أفعال خسيسة لم يستثن الإخوان من صنفها شئ لم يرتكبوه) ربما يفسر الشعور بالخواء الذي تلبس وجداني رغم أنفي، لكن ذلك لم يمنع عقلي من إدانة تلك المشاهد الدموية التي صاحبت فض اعتصام رابعة العدوية.

لا جدال أن عددا من أفراد الجماعة كان مسلحا وأن التدخل الأمني (الذي لا نرفضه في حد ذاته) لفض الاعتصام كان ليستتبع سقوط ضحايا، غير أن الأرقام الضخمة للقتلى، والشهادات التي تتابعت تشير إلى كون الأجهزة الأمنية لم تؤد عملها باحترافية، بل كان يشوبه الانتقام، والتلذذ ـ كذلك ـ أحيانا، ولا غرابة فالجهاز الشرطي ما زال على حاله لم يمسسه معول التغيير، المقلق أن عددا لا بأس به من الحركات الثورية لم يدن بل لم يحذر في تأييده لما قامت به تلك الأجهزة، وهو تأييد يضع اللبنة الأولى لمسار الثورة التي وصفها هيجل بأنها “ذات طابع إرهابي”، هذا المسار الذي سلكته ثورات عدة عبر التاريخ فكان وبالا على شعاراتها وأفكارها التي تحطمت على أيدي أبنائها لا أحد غيرهم. هذا المسار الذي إذا ما أوغلنا فيه لتتشابه ملامحنا وأبناء نظام مبارك، ليغور مشروع الثورة داخل نفوسنا، ولا يبقى غير صراع على السلطة. نعم ربما لم يترك الإخوان بأفعالهم مجالا للتعاطف مع مصابهم، فلم تكن جماعتهم سوى خنجر مسموم في خاصرة الثورة، كلما تقادم عليها الزمن اشتد نزفها بفعله، لكن عقولنا تأبى أن نتردى في وحل لا أخلاقيتهم، إذ هي الخطوة الأولى التي تردي مشروع الثورة. وهو ما افترق عليه رفيقا جبهة الإنقاذ البرادعي وصباحي، فأبى الأول أن يخطو في هذا الطريق، وخطى الثاني خطوة مشئومة.


فارق كبير بين الصورة التي بدا عليها الشعب قبل 25 يناير وصورته بعدها، كتلك التي بين شعب تيبست أطرافه وتجلطت دماؤه وتفحمت جذور الحياة فيه، وبين آخر تدفقت في أوصاله حيوية شابة ليتوقد بجذوة الحياة. ولكل منهما قادته وزعمائه، فالأول له سياسيوه الذين تماهوا مع حالته تلك وألفوها فكانت لهم حياة، والثاني له سياسيوه الذين يتشكلون اليوم ليشكلوا المستقبل في الغد.
وصاحبنا واحد من ساسة الشعب الأول الذين حُق عليهم أن يندثروا معه بغير رجعة.
هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و"المؤسس الثاني" لجماعة الإخوان المسلمين التي لفظته منذ ما يزيد على العام فلم يلفظها، إذ لطالما تصور أنه الجماعة، ومع كون ذلك مجرد تخييل من الرجل، لكنه ما حاد عن تصوره ذاك إلى اليوم، رغم تهميشه لفترة طويلة داخل الجماعة، تبعها إقصاءه من مكتب إرشادها في آخر انتخابات له قبل الموجة الأولى للثورة، وفصله من الجماعة بعدها.
يفصح عما ذهبنا إليه مواقف عدة لأبو الفتوح مع الجماعة، كان من أبرزها وأبلغها دلالة ـ كذلك ـ على الشقاق بينه وبين المجموعة القطبية التي سيطرت على التنظيم بشكل كامل، يوم كشف الإخوان عن برنامج لحزب سياسي في عام 2007، حينها أعلن أبو الفتوح عن تباعده وهذا البرنامج، الذي كان يرفض إعطاء الحق للمرأة والقبطي للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وكان يقر هيئة لكبار العلماء لها الحق أن تصادر قرار البرلمان ورئيس الجمهورية إن بدا لها أنه يتعارض مع الشريعة، وصرح أبو الفتوح يومئذ أن برنامج الجماعة يقول بالمواطنة ولا يميز بين فرد وآخر على أساس من الدين أو اللون أو الجنس، متجاهلا نص البرنامج الذي لا لبس فيه، وتصريحات القيادات القطبية وقتها، التي دافعت عن وجهة النظر تلك، وأصرت عليها.
هذا التعامي من أبو الفتوح لم يقتصر على تلك القضية وغيرها، بل نزعم أنه كان موقفا فكريا يعتنقه الرجل.
عاش أبو الفتوح يظن ـ وبعض الظن غفلة ـ أنه هو الأحق بقيادة التنظيم ليس فقط باعتباره المؤسس الثاني، بل لكونه كذلك وريثا لـ"مدرسة البنا الوسطية" (ألم يقر له القرضاوي غير ذات مرة بذلك؟)، من ثم أرتأى أن القطبيين الذين استحوذوا على التنظيم هم دخلاء، أما هو فأصيل كل الأصالة.
وفي هذا تعاميا عن كون البنا لم يكن يوما صاحب مدرسة فضلا عن كونها وسطية، يُلحق نسبها بالأستاذ الإمام محمد عبده زورا وبهتانا، فوسطية محمد عبده خاضت المعارك الشرسة من أجل آراء تحزبت لها، أما البنا فلم يدعو لطرح فكري بعينه، بل وضع أطر عامة تتيح لكل من يحمل اليافطة الإسلامية أن يتدثر بتنظيمه.
فلا غرو أن جاء سيد قطب من بعده فصب في هذا الوعاء الفارغ أفكاره التكفيرية، فلم يقذف بها الوعاء، وما كان له ان يفعل، ولو جاء آخر وصب بدلا من هذه الأفكار أفكارا أخرى لأخذت مجراها إلى عقول أعضاء الجماعة. ونستدرك فنشير إلى أفضلية أفكار قطب عن غيرها فيما يتعلق بتماسك التنظيم وصلابته.
إذن فكر حسن البنا لم يكن يوما معاديا أو مخاصما لفكر سيد قطب، بل كان حاضنة له، لكن الرجل المتعامي (هو وغيره) اعرض عن إبصار هذه الحقيقة، ومن ثم كانت ادعاءاته في مواجهة القيادات القطبية ادعاءات زائفة، وكانوا هم أقرب إلى الصواب في عدم التفرقة بين ما قال به حسن البنا وما دعا إليه سيد قطب.
وظل الرجل لعقود يتسربل بهذا الوهم، بينما كانت تلك القيادات قد سيطرت على التنظيم وأقصت كل من رأى رأيه، ليعيش فيه مهمشا لا وزن له، ومع ذلك لم يجترأ على قرار الانفصال رغم ضرورته، بعد إعلان نيته للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وبعد أن هدمت الموجة الأولى للثورة الجدر الحائلة بين الساسة والممارسة السياسية الحقة (بخاصة وأنه كان يدرك قطعا أن هذه القيادات لن توليه دورا ذا قيمة في المرحلة الجديدة) إلى أن فصلوه هم، لكنه مع ذلك لم يتلفظ بكلمة سوء عن الجماعة رغم إدراكه لخطورة الأفكار التي يحملها قادتها في بواطن عقولهم على الدولة والمجتمع (والتي صاغوا منها مادة ومنهجا لتربية أعضاء الجماعة عليه)، ورغم كون مشاهداته تفوق ـ قطعا ـ ما قصه صديقيه السابقين أبو العلا ماضي وعصام سلطان، على مدى جاوز الخمسة عشر عاما قبل ارتقاء الإخوان السلطة، من حكايات التزوير والكذب والتكفير والعنف المؤجل، عبر مئات التصريحات وعشرات المقالات واللقاءات التلفزيونية، كذا تفوق ما سطره القيادي السابق بالجماعة ثروت الخرباوي في كتبه عنها، فالثلاثة السابقي الذكر كان أعلى ما بلغوه من مناصب قيادية بالجماعة هو منصب عضو مجلس شورى الجماعة لأبو العلا ماضي، في حين أن أبو الفتوح كان من أقدم أعضاء مكتب الإرشاد إن لم يكن أقدمهم.

الجم الرجل لسانه عدا نقد خفيف نفث به عن غضبه تجاه هذه القيادات، مؤملا أن يأتي اليوم الذي يعود فيه إلى جماعته أو تعود هي إليه.
ووازن الرجل مواقفه السياسية تبعا لذلك، وكان آخرها موقفه من 30 يونيو، فلم يتحمس للنزول، بل وسعى داخل حزبه أن يجيئ القرار بعدم المشاركة، لكن رأي الشباب كان هو الغالب، لهذا لم يبعث برسالة يحث فيها الجماهير على الاحتشاد بالميادين كغيره من مرشحي الرئاسة السابقين (البرادعي وصباحي) بل جاءت رسالته بعد أن تفجرت ميادين مصر بأعداد غفيرة، لم يسبق لها مثيل، ليبعث بشكره وتقديره إليها لنزولها إلى الميادين لإسقاط النظام!.
ثم ارتد الرجل المتقلقل على عقبيه واصفا تدخل الجيش ـ أكثر من مرة ـ بأنه انقلاب عسكري، في تصرف ادهش الكثيرين، إذ تجاوز هنا موقف حزب إسلامي آخر أكثر محافظة، وهو حزب النور، الذي عزف عن النزول بـ30 يونيو ـ بخلاف حزب أبو الفتوح ـ لكنه لم يصف أبدا ما حدث من تدخل القوات المسلحة لإنفاذ إرادة الشعب بأنه انقلاب عسكري!.
وغالب الظن أن الرجل لاح لناظري خياله أن الفشل الذريع الذي لاقته قيادات الجماعة يبعث الروح في حلمه من بعد موات، ليكون هو بديلها المنتظر.
إن هذا السياسي المتعامي المتقلقل هو نموذج لساسة نمت في عهد الأنظمة الاستبدادية وانتمت إليها وإن عارضتها، فأطالت في عمرها بفشلها، وعجزها، وتغافلها، وقلقتها، وها هو وأشباهه ونحن نسطر صفحة جديدة من صفحات تاريخ الأمة يأبون إلا أن يسطروه بمدادهم المغشوش !.
محمد السيد الطناوي


لنا ثورتنا أبية شامخة لا يلوي عنقها الخوالف والأدعياء، ولهم أغراضهم ومطامعهم، لا يُهدأ من سعارها غير المطرقة. لنا قيمنا ومبادئنا جبل أشم لا تزحزحه عواصف المصالح، ولا تهزه أنواء الأحقاد، ولهم أخلاقهم ادعاء كاذب يحتجب وراء نقاب شفاف من الغفلة.
ما أحوجنا لأن نتوقف عن الحركة لنفكر قليلا، فنتساءل: أهذه المعركة التي تدور رحاها اليوم بين العسكر والفلول من جانب، والإخوان من جانب آخر؛ هي معركتنا؟!، ليسلمنا هذا السؤال إلى ثانٍ، الرد عليه يحوي في جوفه إجابة الأول؛ هل انتصر لنا العسكر حبا في قيم الحرية والديمقراطية أم كراهية في حكم الإخوان؟.

لن نخوض في التذكير بما كان، بل نكتفي بالإشارة إلى كون طبيعة المؤسسة العسكرية لا تتيح لأفرادها أن ينحازوا لقيم الديمقراطية وإطلاق الحريات، لذا فانحياز قادتها للموجة الثانية للثورة كان حافزه الأساسي كراهية حكم الإخوان، وإدراك هذه الحقيقة يجلعنا لا نركن إلى حسن النية، فسوءها في السياسة من حسن الفطن، بل هو فرضٌ، التكفير عن إغفاله باهظ الثمن.
إذن فالدعوات المتكررة للنزول بزعم دعم الجيش هي دعوات خرقاء غير مسؤولة، تستنزفنا في معركة ليست معركتنا، علاوة على أنها تمنح الإخوان الفرصة لإشعال الموقف باشتباكات تصطنعها، ولا يغيب عن فطنة اللبيب أن التجاهل هو الأسلوب الأمثل، حتى تخور قواهم فيذعنوا منهكى القوى للموضوع على مائدة التفاوض.
ولسنا بحاجة إلى هذه الفطنة هنا لنقرر أن الأولى صرف جهدنا إلى الإعداد للمعركة القادمة مع الفلول، الذين أصبحت لهم وزارة مزينة بوجوه ثورية.

وإعمالا للمبدأ الذي أرسيناه، القائل بأن سوء النية ـ في هذه المرحلة بالذات ـ من حسن الفطن، فمن المحرم علينا تكرار الأخطاء التي وقع البعض في حبائلها بالموجة الأولى للثورة، فلا يدفعنا الشعور بالامتنان تجاه القوات المسلحة إلى الاقتراب منها للدرجة التي يحمل معها التراجع فقدان للمصداقية (وهو قائم بدرجة ما للأسف الشديد)، كذا على القوى الشبابية العمل على تنظيم صفوفها وإقامة كيانات حقيقية، تتبنى مشروعات واضحة المعالم، فانقشاع الحالة الثورية التي تظلل تحركات كافة القوى السياسية على الأرض، يعني أن البقاء سيكون للأكثر تنظيما، ليتمايز من عمل بجد طوال الفترة الماضية عن ذاك الذي كانت تستخفه تلبية أعداد خفيرة لدعوته على مواقع التواصل الاجتماعي، فاعرض عن بذل أي جهد.
ولنصغي إلى قول الإمام الشافعي: ما حك جلدك مثل ظفرك*** فتول أنت جميع أمرك.
نصيحة يقدمها لنا الإمام صادقا، أن هي عقولنا وحدها التي علينا أن نحك بها الواقع، فالصورة التي صنعها الآخر ليست سوى سراب ـ خادع للأبصار ـ يمنينا بحمر النعم، لنسلم لصانعها أمرنا فيتولاه، له لا لنا. دعونا لا نحث الخطى وراء سرابه، لنسقط بعدها دفعة واحدة بعد أن تكون شفاهنا قد تشققت من الظمأ.

محمد السيد الطناوي
لكم وطنكم الذي قال لي ارحل، ولي وطني الذي يهتف باسمي حبا وكرامة.
قالها مرسي ـ أمس ـ بثبات وصدق ولا غرابة، فقد عاشها ـ معنًا ـ منذ انتمى إلى "الجماعة المسلمة" ليفارق "المجتمع الجاهلي"، أما وقد خرج الأخير ينادي بسقوطه، فهي الحرب الأهلية التي أطلق نفيرها بخطابه، يحسب أن "جماعته المسلمة" تعصمه من دون الشعب "الجاهلي" الذي هدر كالطوفان على طول مصر وعرضها يردد كلمة واحدة، ارحل.
خطب الرجل فيهم لا فينا، ناشدهم أن يقاتلوا حتى النهاية لاستبقاء شرعيته ـ المزعومة ـ عليه، يتدثر بها اتقاءا غضب الشعب الذي ما برح الميادين والشوارع يرعد بكلمة واحدة، ارحل.
خطب فيهم لا فينا، وكأن ميادين مصر وشوارعها لم تضق بكارهي حكمه الساخطين عليه وعلى جماعته، ولم تخرق أصواتهم السماء، فتُسمع أهلها وأهل الأرض جميعا، ليصم هو أذنه عنها.
ثرثر الرجل كعادته، فلم نفد منه غير كلمة واحدة، لو اكتفى بها لم ينقص خطابه شيئا؛ الشرعية. أوليس الشعب صاحبها؟!، يؤتها من يشاء وينزعها ممن يشاء، وقد قالها بليغة تفوق في بلاغتها كلمات المتنبي، فأسمعت كل من به صمم؛ ارحل.
كأن الرجل لم يدرك وجماعته بعدُ، أن الشعب قد تعلم من دفن شهدائه كيف يستنبت الدم فيُنبت له الحرية، وكيف يزرع الدمع فيثمر له العزم، لتخضع الطبائع بجملتها لحساب الضمير الوطني، فإيعازه قدره لا راد له، وها هو أملى الخروج، والنداء بكلمة وحيدة؛ ارحل.
لا غرو إذن أن يهرع الشعب في ذعر لإنقاذ سفينة الوطن التي تصارع الأمواج وهي بدون دفة ولا شراع، أما ربانها فمغيب مسكين لا قدرة له على شئ، وأما ميناؤها فكهف تسكنه الغيلان القراصنة.
لم يعد للحديث معنى، فالفعل قائم يسعى، وما هي إلا سويعات وتنفذ إرادة الشعب حقيقة واقعة.

محمد السيد الطناوي
هو أعظم آفات أوطاننا قاطبة، طالما أمرض جسدها فأقعده عن الفعل الواعي المريد، ليكون مصيرنا كيفما اتفق، ومسبباته طفيليات، أفكارهم وأحاديثهم أفعوانية، يلتهم بعضها بعضا، ليغورالمعنى وتهترأ الكلمات، فلا تفيد شيئا.
وهذه الآفة، الوعي الناقص، أمرضت المجتمع جميعا، فلم تستثن فئة أو جماعة أو طبقة، فمثقفون (طفيليات)، عقولهم في أحسن الأحوال هي من تلك النوعية "المملوءة جدا"، في مقابل "العقول المصنوعة جيدا"(1)، التي كانت دومنا لأعدائنا فطوعوها لتطويعنا وتسيدوا؛ فلا رؤية كلية تُستوعب بها الظرفية التاريخية، وتطرح على الحاضر أسئلة المستقبل. ما أشبههم بطفل لا يدرك المرحلة التي تلفه إلا بعد تجاوزها، لينحصر فعله في دائرة رد الفعل الساذج، ويبقى مصيرنا رهنا بين اصبعي أعدائنا أو الفوضى الخلاقة، إن شاء لها أن تخلق.
تناسوا سلطتهم الأخلاقية لمصلحة ـ ما أسماه المفكر جوليان بندا ـ "تنظيم العواطف الجماعية"، العواطف الطائفية، والأيديولوجية (الموهومة)، ليصبح الواحد منهم ـ بوصف الروائي الفرنسي بول نيزان ـ كلب حراسة، لا أكثر. أوغلوا في استعمال الحيل لإقناعنا بخصب أفكارهم ، فلم تُخف حيلهم عقمهم البادي لكل أحد، رغم ذلك مازالت وجوههم الكالحة تقتحم علينا حاضرنا فيعبس لمرآها المستقبل.
أما جماهيرهم فإدراكها يقف عند العتبة الأولى للوعي (لدى هيجل)، يلقي "الطفيليات" بأقوالهم إليها، فتشتمها ثم تلتهمها في لامبالاة، ليحيك منها الأرذال الوقحون (النخبة) جرأتهم على التصدر والقيادة.
ولو أدركت ذاتها(2)، لو أدركت أن التاريخ لم يجد بغيرها بديلا لقيادة أمتها، حتى وهي تقف محنية الظهر، مطأطأة الرأس، مقيدة بأغلال المستعمر!، لو أدركت أنه وهو المتحجر قلبه، يتهيب أن يهضم زعامتها، وأن يُعمل فيها منطقه الصارم، لعظم قدرها على الأرض وفي السماء؛ لسقطت على هؤلاء (الذين سمموا بلادنا ببلادتهم، وابتذلو شرفها بصغارهم) من حالق فأنشبت مخالبها في أجسادهم، وانتزعتهم من القمة التي يعتلونها بغير حق، والقمتهم فوهة غضبها بلا شفقة.
ويتسلل من وراء حديثنا السؤال يطلب الإجابة، ما العمل؟.
لا حاجة بنا إلى ذلك الديماجوجي المبتسم في وجوهنا دوما، هذا الذي لا يجيد سوى فن التجميل، بل نحن في حاجة لذلك المتجهم الذي يشهر المبضع في وجوهنا، لتندفع يده بمهارة تستأصل الداء الخبيث. نحن في حاجة إلى صاحب الفكرة المتحمسة، التي لا ترتاح إلا بالعمل، صاحب الروح المتطلعة إلى العلا، التي لا تغفو إلا على منكبي اليقظة، الثائر على الأفكار المبتذلة، والتأكيدات المتملقة، لما يريد العامة والدهماء أو الحكام على السواء.
وإذا كان التماهي والتماثل هو الحاكم للمعادلة السابقة، (الجماهير الغافلة والنخبة الفاشلة) فكيف السبيل إلى التولد والتناسل؟!.
لا يكون الارتفاع هنا بالتركيب، فلا وجود للتناقض، بل يكون عبر الاستثناء، ليس من النخبة العاجزة، حتى عن الحلم؛ لكن تنتقى الاستثناءات من جيل وافد على السياسة، لم تمرضهم الشيخوخة ـ في بلادنا ـ بأمراضها، من فساد وعقم وقلة حيلة، بل أسلمتهم فتونة الشباب لسلسلة أحلام، لا تكاد تفرغ من حلقة حتى تنتقل لأخرى، ليتدفق نبوغهم الفردي ـ إن لم يسد أمامه كل مجرى ـ حماسة جماعية، ويفيض على المجتمع نهاية نهضة وتقدم، وقطعا لن يكون هؤلاء بين الذين توطنوا بأرض النخبة فعاشوا في كنفهم، يرددون أحاديثهم، ويعملون في خدمتهم، ويبجلونهم تبجيل المتصوفة للإله.
المحزن ان تاريخنا يزخر بمصارع هؤلاء(3)، بإماتتنا لهم وهم أحياء، لنحيي الأصاغر من الأنصاف والأشباه، ولو قابلنا بين نتاج هؤلاء وأولئك، لكانت أشبه بالمقابلة بين غادات فاتنات كأبهى ما تكون النساء وبين جثث متعفنة تزكم الفطرة السليمة بروائحها!.
ويبقى المجتمع، نساءه تحوم فوق رؤوسهم تهمة العهر، وان احتجبوا إلا عن حُرمهم وملك الموت، ورجاله قوادون وان خدموا المساجد وترهبنوا في الأديرة، أولسنا أجزاءًا من الكل؛ الدولة، أولم نضبطها بالفعل الفاحش مرات ومرات، قبل "الثورة" وبعدها، وكأي بغي إما أن تنافح عن نفسها فتجهر بالإنكار الوقح، أو يرق صوتها بأحاديث الظروف وقصر اليد والضرورة و...إلخ.
ويبقى الخيار ما بين المصابين بسل الروح ، الذين هم نفي للحياة؛ ووافدين جدد تطوي الفكرة دوما جناحيها داخل فعلهم لتتهشم على أرض الواقع فلا يتعرف عليها أحد.
بيد أن هناك خيار ثالث، من دونه نكون أشبه بغابة كثيفة من الأشجار، وإن تعاظمت كثافتها فلا اخضوضر لها ورق ولا تساقط منها ثمر، فهي عطشى لينبوع يفجر فيها الحياة، وما هو غير الرؤية الكلية، والمعنى، يسطع سطوعًا يخطف إليه الأبصار، ويسري نوره إلى الأرواح، فتتطلع إلى مصدره، إلى العلا، لتتقدم نحوه ويكون خلاصها، ودربه مرهون بمقتفي أثره، من راضوا أنفسهم على قراءة السبيل فى ضوء الرؤية الكلية، والمعنى، لتتدفق فصاحتهم كالنهر تعيد الحياة إلى كل من كان لديه منها بقية.

محمد السيد الطناوي
(1) التفرقة لرائد المقالة الحديثة في أوروبا، ميشيل دي مونتين (1533 ـ 1593).
(2) الدرجة التالية للوعي عند هيجل "الوعي الذاتي".
(3) جمال جمدان نموذجا، وقد اقترن عقوق محيطه الأكاديمي، بقطع للرحم من قبل مجتمعه ، فجهلوه حيا، ولم يكرموه حتى بقراءة مؤلفاته، وعند وفاته كان يسير في جنازته بضع عشرات لا أكثر!.
أرمد البصيرة ذاك الذي يظن أن مياه نهرنا تجددت، نهر النظام أعني، بل هي راكدة على حالها، كل ما هنالك، ان حركتنا تسارعت فيه فتوهم البعض تيارا جديدا قد غمره، ومع هذا لا فضاء لغارب سوى القبر، ليقاوم بعنف ضرورة انقراضه، وفي تلك النقطة، كأن الزمن قد توقف بنا، فلا الماضي يمضي، ولا الآتي يأتي، ليتلون الأفق بلون غامض، وتسود الفوضى، فوضى التكوين.
جماعة حاكمة أفكار أبنائها وأقوالهم نبتت من أرض قطبية وغدا تسير عليها أفعالهم، أفرادها يؤمنون بالجماعة لا الوطن، فلا وجود لهذا المفهوم في أدبياتها، إنما هي الأمة، وما دامت الأخيرة غير متعينة على أرض الواقع، فلتكن الجماعة الوطن والأمة معا، وخطورة هذه الرؤية تكمن لحظات انتصاب مصلحة الجماعة في مواجهة المصلحة الوطنية، حينها تُداس الأخيرة، وكأن شيئا لم يكن.
هذه ليست نبوءة بل تسجيل لما حدث ويحدث ليستمر في الحدوث، وأخطر تلك اللحظات يوم يختار أفراد الجماعة بين مصلحتها وخراب الوطن، فتكون هي خيارهم ليتعثر الوطن بها، فيدكها دكا وينهض، لكن الثمن سيكون فادحا.
وإذا شئت فلتعرض تصريحات قيادات الجماعة على القطبية كنموذج تفسيري حتى لا تخلط يوما بين السببية والصدفة، لتتذكر معي "طظ في مصر"، وعن عبد المنعم أبو الفتوح لدى فصله من الجماعة أنه "نقض عهده مع الله"، وأن هزيمة مصر في حربي 56 و67 وسقوط نظام مبارك انتقام إلهي بعد اعتقالات الإخوان، و تعبيرات كـ "الجماعة الربانية"، و"الفلوطة" (الذي يتزوج من غير الإخوانية وإن كانت سلفية)، وغير ذلك كثير، هي انعكاسات لروح تكفيرية، وافرغ كل ما في ذاكرتك من آراء ومواقف لهؤلاء بدت لك غرائبية، لتنتظم داخل هذا النموذج التفسيري؛ الفكر القطبي، الذي البس الجماعة روح القدس، فالمفارق لها مهرطق محروم، والآخر لديها يؤقت وجوده بتمكينها، لكن علينا أن نستدرك فنشير إلى أن هذا النموذج هو من النوع "الاجتهادي"(1)، معني هذا أن نموذجنا لا يدعي ولا ينبغي له أن يدعي قدرة تفسيرية كلية (كالنموذج الموضوعي) أي أنه يفسر إلى حد ما، وهذا الحد يقف عند ممارسات بلغت من الانحطاط الخلقي ما لا يستطيع حتى التقسيم القطبي للمجتمع (جماعة مسلمة ومجتمع جاهلي) أن يستسيغه أو يشرعنه.
نعم سلطانهم نكسة للثورة كتلك التي حطت على ثورات كثيرة عبر التاريخ، لنذكر منها الثورة الفرنسية، شبه كبير بين ثورتنا (التي لم تكتمل) وتلك الثورة الأوروبية، وهم "يعاقبة" ثورتنا، وإن بركان أحقادهم الحي لمرشح للفوران لتندفع من فوهته حمم الدماء أكثر فأكثر!.
نتيجة أخرى تطل برأسها من نموذجنا التفسيري أن الجماعة لن تقف عند أخونة الدولة، بل أخونة المجتمع جميعا هو مبتغاهم، وبعبارة قطب "إلغاء وجود قائم بالفعل لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته"!. وما السيطرة على مؤسسات الدولة سوى هدف مرحلي لا غاية نهائية، لتكون تلك المؤسسات أداة أسلمة "المجتمع الجاهلي" نهاية.
والمخيف أن المشروع الإخواني للسيطرة يسير بخطى ثابتة وإن انعكست في صفحة عقول النخبة (الليبرالية واليسارية) كخطوات مضطربة، كذا فإن تنظيمات هذه النخبة التي أنشئت على عجل لا تنبأ بقدرة على المنافسة قريبة، فعوضا عن كونها اصطنعت لخدمة طموح أشخاص بعينهم، تشي بذلك أفكار مهوشة وأيديولوجيات هشة، فإن أبنيتها يزيدها تصدعا (وبخاصة تلك التي يعتلي قيادتها نجوم لامعة) جماعات الانتهازيين والوصوليين التي تراكمت طبقاتها، فأطبقت على أنفاس الشباب، ليلهثوا وهم في أماكنهم بلا حراك(2)، لتلوح نذر انهيارات بها في الأفق، والانتخابات التشريعية مفتتح البداية، بل إن الجبهة التي تمترسوا داخل أسوارها سرعان ما سينسل منها الحزب تلو الآخر، وفي المقدمة الأحزاب الليبرالية حليف الإخوان بالمرحلة المقبلة إن سارت الأمور في مسارها الرتيب بلا مفاجآت.
إذن نحن أمام جماعة فكرها فاسد وعزمها صلب لا يلين، لا تسمح بوجود الآخر (الجاهلي)، فوجوده مؤقت بتغلب "الجماعة المسلمة"، وقياداتها لم تعرف التبطل (كالنخبة) يوما بل قضوا أعمارهم في عمل تنظيمي مضن كان نتاجه ما نرى، ونخبة انتهب الإعلام جهدها، وتتوقى العمل الجاد كما يتوقى الحر مدارج الهوان، وشباب غاضب يتخبط بين جنبات رد الفعل، وعلينا أن ندير الكلام بيننا بعد ذلك عن هذا المشهد كما لو كان خصبا أو قابلة للإخصاب!.
لا بديل في هذه المرحلة عن وجود حكومة تكنوقراط تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لتقيم دولة مؤسسات حقيقية، أما الحديث عن حكومة وحدة وطنية فهو حديث فارغ، لأن تلك النخبة ـ الأرض التي مات في تربتها الجدباء كل أمل بذرناه ـ ستقسمها إلى مناطق نفوذ.
بالطبع هذه الرؤية لا أمل لإنفاذها إلى أرض الواقع حاليا، لأن من في السلطة الآن لا يسعون إلى إقامة دولة ديمقراطية حديثة، بل جل طموحهم أن يؤسسوا لدولتهم، والوقت خادم أمين لهم ما دامت السلطة بأيديهم، إذن هي موجة ثانية للثورة أعظم ارتفاعا من الأولى تكسح تسلطهم، وشروطها حاضرة على أرض الواقع كما حددها لينين عندما تحدث عن "الوضع الثوري"، فقد اشترط للثورة نشوب أزمة في القمة؛ أي لدى الطبقة السائدة، فلا يكفي عادة أن "لا تريد القمة بعد الآن" بل أن "لا تستطيع القمة ذلك"، وهو وضع قائم بالفعل؛ إذ أن مؤسسة الجيش لن تكون قادرة على الاحتفاظ بكينونتها كمؤسسة وطنية إذا تطاول حكم الإخوان، والمعادلة هنا صفرية، "إما..أو"(2)، والشرط الثاني الذي أبرزه لينين هو تعاظم بؤس الطبقات الدنيا، وهو ماثل أمامنا في ظل أزمة اقتصادية خلقها سوء الإدارة، من ثم تكون الجماهير مدعوة بفعل الأزمة أو بدافع من "القمة" (أو الإثنين معا) إلى الثورة.
يبقى عامل أخير لم يورده لينين في أسباب الثورة (وما كان له أن يذكره بحكم الأيديولوجية الماركسية)، وإن كان فاعلا رئيسيا حتى في ثورته، أنه "المعنى الذي يسكن جوف كل فعل .. فيبلغ به أقصى مدىً له"(4)، وهو في حاجة لأن يسكبه أصحاب القدرة في نفوس الناس لتتكون الإرادة التي "هي حلقة الوصل، بين العالم الخارجي متمثلاً في هذه العناصر (المعطيات التي ذكرناها)، وبين الفكرة أو المعنى، لينتج عن هذا الائتلاف الفعل"(5)، ولا أقصد بالمعنى هنا فكرة مبتسرة كتلك التي تسلطت على فعلنا، فكانت الموجة الأولى للثورة، بل فكرة مكتملة، انعكاسها على أرض الواقع لا يقف عند حد الهدم، بل يقيم بناءا عظيما يقينا قيظ التبعية، وتنتصب قامتنا عند منتهاه لتتلقى وحي القدر، قدرنا الذي جحدناه طويلا، وتلهينا عنه بصغائرنا، لينصرف عنا وينتظر مترقبا.
معضلتنا هي الزمن، فأذرع الإخطبوط الإخواني تمتد إلى مؤسسات الدولة، وقد بدأت عملية إحلال وإبدال، لتسير وتيرتها بانتظام، لا يبالي بصيحات معترض أو لعنات لاعن، وكلما تقادم الزمن كلما كانت خسائر التغيير أكثر كلفة، ولو قدر للجماعة أن تعشش داخل أجهزة القمع بالدولة (الشرطة والجيش)، فالموجة الثانية للثورة مرشحة لأن تتمثل النموذج الليبي أو السوري.
الخلاصة، أن أطروحة الاستبداد ببلادنا قد جاوزت المدى، وآن آوان طباقها(6)، لكن التاريخ عودنا أن لا يكون على عجلة من أمره، يسير الهوينى في برود، غير عابئ بآمال وطموحات بل وبأجيال تتهشم تحت قدميه الهمجية، من ثم لا مانع أن تُدفع كرة التغيير من "القمة". وهي دعوة للقمة أن تُقدم، وللثورة أن تتعقلن بالواقع، حتى لا نقدم له ذريعة بقاء وحجة تأبد، وإن كان نسبيا.
(1) المصطلح للدكتور عبد الوهاب المسيري، ويأتي في مقابل النموذج الموضوعي المادي الذي يتجاهل تركيبية الإنسان، ويتعامل معه ككائن مادي يتحرك في بيئة مادية ويرصد بشكل آلي.
(2) يؤيد زعمنا تلك الكلمة التي ألقاها الدكتور حسام عيسى مسؤول الهيكلة بحزب الدستور في استقالته، والأمر الذي لم يتوقف عنده أحد أن المسؤول التنظيمي الأول في الحزب الكبير لم يكن يملك خبرة تنظيمة تقدر بيوم واحد قبل توليه تلك المسؤولية!، وليس حال الأحزاب الأخرى بأحسن منه.
(3) إن القلق من تدخل الجيش يجب أن يكون في أدنى درجاته، لأن تجربة الحكم التي خبرها بعد سقوط مبارك قد كسرت حدة شهوة السلطة لديه، وتعقلنت قياداته بالواقع الذي جهر في وجوههم بحقيقة أن عهد الحكم العسكري قد مضى بغير رجعة، وان تحدي تلك الحقيقة التاريخية سيكون مكلفا لدرجة صفرية.
(4) (محمد السيد الطناوي، الإنسان الأعلى، "الإنسان الأعلى والحرية"، ص88، زهراء الشرق)
(5) السابق، ص71
(6) طبقا للديالكتيك الهيجلي (الأطروحة ـ الطباق ـ التركيب)

الكاتب/ محمد السيد الطناوى

ابتلعه التاريخ في جوفه ومضى، لكن طيفه مازال مرتسما في وجه الشمس عصي على النسيان.
هو واحد من تلك الأجسام الكبيرة التي تحني الفضاء والوقت معا، لينجذب إليه كل شئ في محيطه، فتدور كالكواكب في فلكه على غير إرادة منها(1).
بالأمس القريب وقد كان الضباب يغمر وجداني فإذا أتى ذكره على مسامعي تمتمت بعبارات غاضبة حانقة، وانطلق لساني يلعنه كما تعود أن يلعن في آلية كل طاغية مستبد، واليوم وقد بددت رياح الزمن ذاك الضباب، تساءلت معاتبا نفسي أكنت أريد من القدر ـ حين بعثه فينا ـ أن يكون كالمصور الكذوب الذي يرسم وجه امرأة مجعد حفره عمرها المديد بالأخاديد ليجئ بلوحته ناعما متناسق الخطوط بديعا؟!، هو ابن قصتنا، تلك التي لا يسأم رواتها من ترديد أن الطاعة للحاكم علينا واجبة ولو جلد ظهورنا وانتهب أموالنا، وأن السلطة لمن غلب يلهو بها كيفما شاء هواه!. فما كرهناه منه هو من صنعنا؛ وقد فطن أناسه لذلك (وإن كانت فطنة لاوعية)، فجَلدوا لطغيانه باسمين إلا أولئك الرواة إذ ساءهم أن لا يحني قامته المديدة ليلتقط من واديهم الحصى لمسبحته.
لم يخلق خلقا جديدا بل ردد على مسامع الناس ما كان مكنونا بقلوبهم فقدسته، وتسلط على خيالهم بأحاديثه فانقادوا إليه حبا وكرامة(2)، ثم تبع أحاديثه بأفعال ـ وإن كانت ناقصة ـ لتعظم مكانته في نفوسهم.
لم يسر بهم على طريق يسيرة هينة كتلك التي ارتادها خلفائه بل تقدمهم في درب وعرة غير مطروقة لتدمى أقدامهم، وتصطلي جباههم بلظى غضب الامبريالية المجرمة، إلا أنهم سعدوا في المسير وراءه. وعندما انحجبت روحه وراء نقاب الأبدية غمرت الجماهير جثمانه بالعويل والبكاء حتى أولئك الذين احتُفرت ظهورهم بسياطه الحامية قرعوا الصدور حزنا عليه.
ولتتغذى أسطورته بنهم من أقاصيص خلفاءه الصغار، ثلاثة خلو من أي مهارة، اللهم إلا خليفته الأول إذ اختص بواحدة؛ مهارة الحواة، وهي لمن لا يعرف فارغة من المعنى، أما الثاني فيكفي توصيفه بأنه فرد احتل لفترة ما حيز في المكان، لكن الصدفة وحدها شاءت أن يكون هذا الحيز عرش بلادنا التعسة، أما الثالث نكبتنا الحاضرة، فهو فارغ من المعنى كسابقيه غير أنه ثرثار تلك ميزته الفارقة.
ولشد ما هو الشبه بين الثلاثة إذ أن كل واحد منهم كان مسوغ اعتلائه السلطة القزمية وكونه مأمون الجانب، وهي لعنة قديمة لم ترفع عن بلادنا بعد، قاعدة عامة وإذا كان لها استثناءا فهو ذاك الذي لا حكم له، ما هي؟ أن كتب عليها بأن "تسمح للرجل العادي المتوسط بل "للرجل الصغير" بأكثر مما ينبغي وتفسح له مكانا أكبر مما يستحق"، لـ "تضيق أشد الضيق بالرجل الممتاز"، ولـ"تلفظه بانتظام وإحكام".
هو نبأ ساقه إلينا خبير مصر المتفرد وعاشقها العظيم جمال حمدان، فلا يظن بصدقه الظنون.
ولنتبع أستاذنا الجليل في حماسته المتطرفة وهو يحادثنا عن ناصر، إذ يقول: "إن الناصرية هي المصرية كما ينبغي أن تكون.. أنت مصري اذن أنت ناصري... حتى لو انفصلنا عنه أو رفضناه كشخص أو كإنجاز..المصري ناصري قبل الناصرية وبعدها وبدونها.. كل حاكم بعد عبد الناصر لا يملك أن يخرج على الناصرية ولو أراد الا وخرج عن المصرية أي كان خائنا".
إن المعنى الذي يطل بوجهه من كلمات حمدان قويا سافرا أن سياسات ناصر داخلية وخارجية كانت قدر مصر، من حاد عنها لا يعد فقط خائنا لمصر بل كافرا بالقدر كذلك.
وها هي مصرنا وقد أقدمت فرحة مستبشرة بعد مشهد ثوري أذهل العالم تشرب من كاسات قدمها إليها أبنائها ظانة أنها ذات الكاسات التي شربت منها في الزمن الماضي وكانت تقبع بها حيويتها، فإذا هي وقد تجرعت مذق مسمم استقطرته يد الإثم من مستنقع الجهالة تسقط مريضة محمومة، ولا عزاء للخونة.
(1) الفكرة الرئيسية لنظرية النسبية العامة لأينشتين، والتي كشف عبرها عن سر الجاذبية.
(2) الناس أطوع لخيالهم منهم لعقولهم "ابن سينا".

بقلم / محمد الطناوى
هي رهينة الوعي بضرورتها، وهذا الوعي لا ينهض إلا من بين ثقافة قد وطئت للديمقراطية موضعا في نفوس أبنائها، فربما الشعور بالحاجة الآنية لها وحده لا يكفي لارتقاء ذلك المرتقى الصعب. قول يلزمه التعقيب لتوضيح ماذا نقصد بضرورة الديمقراطية من جهة، وكيفية تأسيس الوعي بها من جهة أخرى.
الضرورة اصطلاحاً هي "النازل مما لا مدفع له"، وهذا المعنى يشرف بنا على ما نود قوله؛ فالإيمان بالديمقراطية ينبغي أن تدفع به الأيديولوجية بصفة خاصة، والمرجعية الحضارية بصفة عامة، أي أن يكون جوهرا (وهو معنى الكلمة "الضرورة" في المعجم الفلسفي) لا عرضا، والجوهر كما يعرفه الفلاسفة هو "ما يكون قائما باستمرار وسط التغيرات التي تطرأ على الشئ"، وهكذا ينبغي أن تكون الديمقراطية، لكن هل هي حقا كذلك في أوطاننا، أم أنها حاضرة فقط بالقوة لا بالفعل؟، إذ لا الأفكار المهوشة ولا النفوس المتشككة ولا الأفئدة الوجلة من سلبياتها بقادرة أن تثابر لتقيم بنائها بكل تفاصيله الهندسية المعقدة.

الديمقراطية لدى تياراتنا الفكرية
رغم دعوتهم للديمقراطية ورفعهم لشعارها، لكن هذا لم يمنع الليبراليون من التشكيك في إمكانية تطبيقها بمجتمعاتنا تطبيقا سليما، ليؤيدون رأيهم بأحاديث عن مجتمعات لم تتطور بعد إلى مستوى المجتمع الصناعي الرأسمالي، واقتصاديات ريعية لدول منها ما هو قائم على التحويلات المالية لمواطني الدولة في الخارج وعلى القروض والهبات وعائدات القطاعات الخدمية كالسياحة وغيرها، ومنها ما هو قائم على عائدات النفط والثروات المعدنية؛ وعن حاجز من ضعف الوعي يحول بين الجماهير وبين الإقبال على الخيار الصحيح لإنجاح الديمقراطية الذي هو بالطبع خيار الليبرالية.
أما اليسار بطوائفه فإيمانه بها ربما يكون أشد وهنا، إذ الماركسيون كما هو معروف في أدبياتهم، يرون الديمقراطية ليست سوى خدعة يخرجها البورجوازي من جعبته ليخطف أبصار البروليتاريا إليها بينما هو يسطو على حقوقهم ويسرق أقواتهم.
في حين أن الفكر القومي كما جسدته التجربة الناصرية ببلدنا، قد قدم "الديمقراطية الاقتصادية" أو الحرية الاجتماعية على الديمقراطية السياسية، التي لم تكن سوى "ديمقراطية الرجعية"، أو هكذا ارتآها، ووازى ذلك أو سبقه في ترتيب الأهمية القضايا القومية لتتوارى الديمقراطية ورائهما في حياء لتواضع مكانتها.

والحديث عن فكرة الديمقراطية لدى الإسلاميين يطول بطول تاريخنا الإسلامي، فالديمقراطية في عقولهم قد تسربلت بلباس ضيق، لباس الشورى؛ فقد ولدت هذه الفكرة على يد الإسلام في عصر كسرى وقيصر فعاشت غريبة فيه، إذ كانت سابقة لزمانها، لكنها لم تتطور على أرض الواقع بل سرعان ما ارتدت ـ بعد أن عاينها الناس قائمة بينهم ـ إلى عالم الأفكار على يد حكام طغاة، ليتناوبها فقهائهم؛ فقهاء السلاطين، بالقول الفاحش، فجعلها قسم منهم "معلمة لا ملزمة"، وليجتمع جلهم على حصرها في نطاق ضيق خانق لها، هو نطاق"أهل الحل والعقد"، وبذا فبدلا من أن تنمو وتزهر ذبلت لتستقر صورتها الذابلة تلك في وعي كثير من الإسلاميين، وحتى من تجاوزها منهم فإن "لاوعيه الإسلامي" حال دون نشوء إيمان حقيقي بحتميتها،
لذا لا مجال للدهشة إذا ما تحدث الإمام الإصلاحي إمام مدرسة التجديد (محمد عبده) عن "المستبد العادل"، الذي "يصنع في خمس عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده فى خمسة عشر قرناً"!.
ورغم ذلك فقد كانت الديمقراطية مطلب الجميع المعلن وبغيتهم. ويسقط النظام عبر ثورة (لم تكتمل بعد) لتجنح فيِ عُرْضِ طريقها بالإسلاميين، فتخفت نبرة أحاديث الديمقراطية على ألسنتهم، وتنطلق صيحة أخرى، صيحة الإسلام الذي قامت له دولة، ويحاول أعدائه أن يحولوا دون رسوخ أركانها، وإقامة شريعتها، ورفع لوائها، فهي معركة دينية، تستباح فيها حتى تعاليم الدين ذاته، للدفاع عنها!.
لكن أكان الأمر يختلف كثيرا (بالنسبة للديمقراطية) لو كان غير الإسلاميين هم من ارتقوا السلطة وحازوا مفاتيحها؟، لا أظن ذلك، هي ذات النتيجة وإن اختلفت التبريرات، إذ لارتفعت عوضا عن هذه الصيحة مقولة حماية الديمقراطية من أعدائها الكافرين بها، الذين يبتزون عدم وعي الجماهير بقصد خداعهم وتضليلهم، أو لارتفعت خفاقة راية الذود عن الدولة ضد التنظيمات والجماعات الرجعية التي تريد أن تغرق الوطن في بحر الماضي الآسن.
أيكون من فضلة القول إذن أن نشير إلى كون تلاوة أحاديث الديمقراطية ـ في العهد السابق ـ من قبل الكثيرين ببلدنا لم يكن دافعها سوى التطير من شؤم نظام الحزب الواحد المستتر بتعددية زائفة؟!، لكن حتما علينا هنا أن نستدرك لننفي عن أنفسنا خطيئة التعميم.

تأسيس الوعي بالديمقراطية
وإذن هي إرادة الديمقراطية التي وجب على فرقاء الوطن أن يمدوا أيديهم إليها لاستكمال تشكيلها لتسعى من بعد إلى أرض الواقع، وهذا يتطلب بداية استكمال تأسيس الوعي بها ليرقى إلى درجة الإيمان الصادق، لا الإدعاء الهش الذي تدوسه أقدام الاختبار الأول غير عابئة، ولا نستثني بحديثنا أحداً من أولئك الفرقاء.
وهذا التأسيس أو لنقل استكماله يتطلب سد الفجوات التي تخرق نسيجه، ويكون ذلك عبر تمثل حقيقة حتمية الديمقراطية رغم كل عيوبها وثغراتها التي قد تنفذ منها الضمائر الخربة للسطو على مقدرات الوطن، حتى وان اتسعت تلك العيوب بفعل مجتمعات لم تتطور بعد إلى المستوى اللازم للممارسة الديمقراطية ممارسة سليمة (نسبيا)، فالبديل هو الاستبداد الذي لا حصر لعيوبه، وإن حصرها "مستبد عادل" في فرجة ضيقة سدها بعدله، واستطاع أن يختصر الزمان بقدراته وحزمه، ذلك الذي تسير الديمقراطية عبره سيرا بطيئا؛ إذا عولنا على مصادفة كهذه (وغضضنا البصر عن التناقض النظري بين الاستبداد والعدل)، فما الذي يحول دون أن يأتي من بين خلفائه مستبد غير عادل ليسلم ما أقامه سلفه للخراب (ارجع لتاريخنا ستجد به أمثلة قريبة الشبه من هذا النموذج) ؟!.
وليدرك الجميع كذلك أن العقل الجمعي لشعب من الشعوب لا يعتمد سوى ما خبره هو(بخلاف العقل الفردي)، فلا مجال للقفز فوق حتمية تاريخية.
كذا هناك من هو في حاجة ـ من بين تياراتنا السياسية ـ لأن يدرك الديمقراطية كتوأم غير ملتصق بالرأسمالية، نعم ربما قد نشأ ودرجا معا في أحضان التجربة الغربية، لكن الأولى كانت بمثابة الكابح لنهم الثانية المتوحش للاستغلال والاحتكار عبر مؤسسات رقابية وآليات للتغيير السلمي.
الخريطة الزرقاء للديمقراطية
ولنعلم كذلك أن التوق للديمقراطية وإن لف الشعب بأكمله، لما تحقق لها وجود على أرض الواقع إلا عبر إرادة واعية ليس بما ستواجهه من تحديات هائلة داخلية وخارجية فقط بل واعية كذلك بخريطتها الزرقاء(1)، التي أبرز خطوطها "دمقرطة الاقتصاد"، أي الانتقال من اقتصاد الريع القائم على تحويلات المغتربين والقروض والهبات والقطاعات الخدمية كالسياحة وغيرها، والتي تضخ دماء الحياة في أوردة الدولة الديكتاتورية لتزيد من إحكام قبضتها على المجتمع (إذ تنفق الدولة منها على تغذية مؤسساتها وتضخيمها وتدعيم أجهزتها بخاصة القمعية منها بعيدا عن رقابة دافعي الضرائب)؛ إلى اقتصاد قائم على الإنتاج وبالتالي فموارد الدولة يكون مصدرها الرئيسي الضرائب، ليزيد ذلك من إحكام قبضة المجتمع على الدولة، لا العكس.
وهناك عامل ثان أو خط آخر يتقاطع على خريطتنا الزرقاء مع "دمقرطة الاقتصاد"، وهو خط مؤسسات المجتمع المدني سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، إنها البنية التحتية للديمقراطية، وهي ليست مجرد هياكل وتنظيمات بل هي قبل ذلك ثقافة لزاما على المجتمع أن يتمثلها لتتغلغل في ثنايا وأروقة عقله، ولن يحدث ذلك قبل إعلاء القيم الحاضنة لتلك الثقافة.
وخط ثالث يبرز على تلك الخريطة (ربما لم تشر إليه أدبيات العلوم السياسية)، ويتمثل في الشروط الواجب توافرها بنخبة التأسيس؛ تأسيس الوعي، فعوضا عن صلابة إيمانها بالديمقراطية ووعيها التام بخريطتها الزرقاء، يلزمها أيضا نضج فكري وجداني يجعلها تختصر الزمان، وتغني شعبها عن خوض وحول التجارب المريرة التي تعترض الطريق إليها، كذلك يعصمها من فتنة الدين الجديد لعصرنا، الذي يعيث إلهه فسادا بمجتمعاتنا بصورة أكثر اتساعا من مجتمعات الدول المتقدمة، "إله عصر ما بعد الحداثة"؛ إنه الإعلام بأجهزته المختلفة التي تُيمم النخبة وجهها إليها من دون المصلحة الوطنية، فتقيم المؤسسات من أحزاب وحركات وجمعيات ومنظمات..الخ لا لتخدم عبرها الناس بل للتذلف بها إلى ذلك المعبود الجديد، ولتنحني قامات الكبار بمعبده خاضعة لأوامره ونواهيه، (بل إن منهم من يعلن العصيان ضد الحكام ليطأطأ الرأس في حضرة معبود العصر ذاك!)، وإليه تُبذل قرابينهم من دون الناس، ومن واقعنا التعس المثال، فكم من حزب يخرج علينا قياديوه في كل يوم بمبادرة لا تهدف لغير أن تُذكر أسمائهم على لسانه، كذا لا تنشط نفوسهم إلى عمل إلا إذا صحبتهم إليه عيونه (كاميراته) ترصدهم، وهنا لا نستدرك لننفي عن حديثنا التعميم، فهو ليس بخطيئة في موضعنا ذاك.
وبعد، فهناك العديد من الخطوط التي تمتد وتتشعب على خريطة الديمقراطية الزرقاء، وهي أهم خطوطها تلك التي رسمناها أعلاه، لكن الصراع السياسي المحتدم في بلادنا قد رقق تلك الخطوط فلطفت إلى حد الخفاء لتبرز أخرى دقيقة فتخطف إليها الأبصار، وتبعد الشقة بذلك بيننا وبين مبتغانا في تأسيس الوعي بها!.

إذن هو وعي بضرورة فإرادة ففعل، معادلة جد بسيطة، لكن إنفاذها إلى أرض الواقع جد عسير، وهو وهم يحاذر عقلنا أن يقع في حبائله فيتصور أن طرحنا ذاك يمكن أن يتسلل إلى عقول تلك النخبة الطافية على سطح الساحة السياسية ببلدنا، فتتقدم إرادة أفرادها على طريق الديمقراطية القويم ولو خطوة واحدة، إذ هي إرادة شوبنهاورية(2)، ولأن لا أحد منهم مبدع ولا زاهد لذا لا يستطيع الواحد منهم أن يفعل غير ما يفعله منذ عقود، بل نبث حديثا إلى ذلك الجيل الذي لم يفعل بعد، نحضه أن يزدري تلك النخبة وما ترسله من أحاديث وآراء مشئومة، فكل ما ذكرناه آنفا من توجهات ورؤى هو نتاجها، وأن يقبل على تأسيس وعيه بالديمقراطية، فيلتمس لذلك مظانه المعتبرة، وننبئه مجددا أن لا الأفكار المهوشة، ولا النفوس المتشككة ولا الأفئدة الوجلة من سلبيات الديمقراطية يمكن أن تثابر على إقامة بناءها بتفاصيله المعقدة، إنما هو وعي مريد أو إرادة واعية.
(1) خريطة التصميم المعماري
(2) الإرادة لدى شوبنهور هي الرغبات واللذات والشهوات التي تحرك الإنسان دون وعي منه، ولا أحد بقادر أن يتغلب على إرادته ـ وفق هذا المفهوم ـ سوى المبدع لحظة إبداعه، أو الزاهد الذي يتسلط عقله على تلك الإرادة فيضعف من أثرها.

بقلم / محمد الطناوى
ـ متميع لم يطلق يوما كلمة تؤذي مشاعر النظام، ولو أفلتت من تحت لسانه واحدة، ارتجعها سريعا وإن سممت روحه، لذا تجده قريبا من كل نظام ناصري كان أم ساداتي أم مباركي أم مهيطلي، وهو واحد من أولئك الذين قيل فيهم لن يدخل محامي الجنة وهناك مقعد شاغر في النار، لا لشئ إلا لأنه لم يقل يوما كلمة حق عند سلطان جائر.
ـ وسفيه ينتحل صفة مؤرخ طل علينا لأول مرة عبر عرض سخيف لإمرأة لعوب، فأصبح ضيفا خفيفا عليها في عروضها الأسبوعية، ثقيلا على كل من عداها.

ـ وإخواني يستعمله سادته القطبيون في أغراضهم كأداة رخيصة، لا تكلفهم شيئا، ينتمي إليهم وليس منهم، ولو كان ذكيا كما يعتقد في نفسه لاعتبر بمن تقدمه في ذات الوظيفة، وقد فاقه في مدة خدمته، وعلو كعبه، ثم ماذا؟! لا شئ (إذ كان عضوا بمكتب الإرشاد وقد عبر إليه بشق الأنفس، وبعد طول خدمة، ليخرج منه ويعين نائبا لحزب "الحرية" ليترك المنصب سريعا، ويعين مستشارا للرئيس لبضعة أشهر فقط ، فرئيسا للكتلة الإخوان بالشورى، وبعد أشهر يخرج للعراء خالي الوفاض من كل منصب، بل عاريا).
ـ و"راقصة" ـ بماخور بالمقطم ـ اعتادت أن تتمايل بخلاعة فجة بلا أدنى شعور من حياء، فاكتسبت سمعة وشهرة فاقت بها كل أقرانها، وكان آخر عروضها "معركة الرئاسة"، فتمايلت على العوا حينا ـ بل أغرته بدخولها ـ ثم تركته لزبون آخر "أبو الفتوح" فتغنجت عليه وداعبته لعلها تتحصل منه على ما لم تُحصّله من سابقه، لتسقط أخيرا بعد أن أعياها التعب في حجر مرسي، فينقطها الشاطر بملايينه.
ـ وصبي راقصتنا تلك، أحضرته من لجنة قانونية زعموا لها أنها القادرة على استرداد أموالنا المنهوبة، لتعبر به من باب ماخورها قياديا، وليتقدم بعد ذلك في فضاء الساحة السياسية والإعلامية فيصبح ملئ الأسماع والأبصار، وليداوم على المزايدة بوقاحة لا تستغرب من "صبي راقصة" على من كانوا يجأرون في وجه نظام ديكتاتوري لم تُعرف له يوما صيحة ولو خافتة في وجهه.
ـ وأستاذة جامعية اشتراكية الأيديولوجية، أو هكذا تدعى، لكن هواها وسط ي، ولو دخل قيادات ماخور الوسط ية تلك جحر ضب لدخلته وراءهم، لتخون كل ما تؤمن به أو تدعي ايمانها به.
ـ ومفكر "إسلامي" ناشدوه قبل الثورة أن يُقبل ليحمل ذات الراية التي رفعها البرادعي من بعد، فاعتذر بحجة أن عمله لا يخرج عن دائرة الفكر والكتابة هذا لما كانت السياسة مغرما فلما صارت مغنما اعلن الشيخ العجوز أنه كان يمارس السياسة منذ أن كان ابن العاشرة ( ذكر ذلك في تصريح له)، وأن باستطاعته إدارة دولة، بعد أن كان غير قادر على إدارة مكتبه الذي يضم بضعة محامين!، ليَقبل شاكرا بعد سقوطه المدوي بأن يكون ظلا باهتا في خلفية خصمه السابق الذي لم يك يراه شيئا !!.
ـ وأستاذ جامعي وكاتب، إصلاحي قبل الثورة، ثوريا بعدها، لكنه ثوري ملتصق بالنظام فتنقل بين وظائف استشارية ديكورية أتاحها له النظام، ولما لفظته أو ملها إذ لم يجد من وراءها نفع يذكر، صادق فل من الفلول ليقنع ـ أسفا كاسف البال ـ بكونه فحسب ضيفا دائما عليه بمصطبته الفضائي( واحد صديقه ميكانيكي هيطلع إيه وزير!!).
أأنتم أصحاب الضمير فينا؟!!! يا لوقاحتكم السافلة!!!.

بقلم / محمد الطناوى
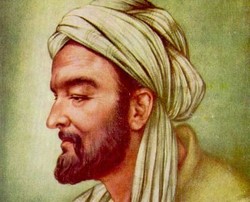
يرجع مولده إلى أكثر من ألف سنة خلت، وإن كان هناك عبر التاريخ الفكري من هو أسن منه، غير أن من طاوله منهم قهره، ومن زاحمه مكانته رده مدحورا مهزوما.
لم يسم في العربية بهذا الاسم أحد قبله، فجاءا فريدا في اسمه كما تفرد بآراء ونظريات حواها في جوفه، وقدرت له حياة طويلة عريضة، قضاها بين جنبات مئات بل آلاف من الطلبة والباحثين، أنفقوا في وصله بياض أيامهم وسواد لياليهم، ليشيبوا وهم على حالهم من الاغتراف من نبعه لا يغوره الزمان.
مثّل الثقافة العربية في سموها ودنوها؛ سموها حين تلم بدقائق المعاني الكبرى فتجلوها وتقدمها مضيئة واضحة القسمات، ودنوها حين تتصل بالقلوب فتملك عليها أزمتها وبالعقول فتأخذ منها بزاد كبير.
جاء شاملا شمولا ـ في المجالات التي تعرض لها ـ يأبى النقصان، كأن صاحبه أراد أن يودعه نفسه التي كادت أن تطوي الكون بكامل أسراره داخلها، فأعيى قلمه دون أن يبلغ مرامه؛ فتحت المنطق استقر الشعر والخطابة، وتحت الطبيعيات ألحقت الجيولوجيا بعلم الحيوان، وعلم النبات، وعلم النفس، وقوانين الحركة والتغير، وتحت الرياضيات تراصت الهندسة إلى جانب علم الحساب وعلم الهيئة وعلم الموسيقى، وتحت الإلهيات استقرت الفلسفة الأولى فعلم السياسة والأخلاق، ليبلغ بنا العجب مبلغه إذا عرفنا أن صاحبه قد زاد عليه أكثر من مائتي مؤلف سابق ولاحق له!.
أما صاحبه فهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، أعجوبة زمانه. ومثله مثل كل بني جنسه من ساكني وادي عبقر صعد به محبوه إلى أعالٍ لم يبلغها سواه، ليجره حاسدوه ومنكروه إلى مستنقع موبوء بكل الموبقات!؛ فهو "المثل الأعلى للفلسفة في القرون الوسطى"(جورج ساتون)، وكتابه "القانون" هو الإنجيل الطبي لأطول فترة من الزمان (سير ويليم أوسلر)، وكتابه الإشارات هو "قرآن الخاصة" (التسمية لنصير الطوسي، في حين كان يسمي المصحف ب"قرآن العامة"). وهو أيضا الزنديق القرمطي شارب الخمر الكافر إمام الملحدين!.
ولم تك حياته بأقل اضطرابا من سيرته عند مبجليه ومزدريه، فهو الشيخ الرئيس الذي استوزر لدى عدد من ملوك وأمراء عصره، ليعيش حياة رغدة كريمة، وهو السجين المطارد المنهوبة أمواله وكتبه!. فكأنما القدر قد شاء لحياته أن تجئ شبيهة بمعزوفة شرقية ـ من تلك التي كان يحلو له أن يطبب بها مرضاه ـ عمد عازفها إلى التلاعب بالإيقاع وبالنقلات المقامية بها، ليطرب سامعيه عبر المفاجأة غير المتوقعة.
هي قصة نفس هبطت من محل متعال عن الأرض، فجاءت إليها كارهة، واتصلت بالبدن كارهة، تلبسته أو تلبسها لتضطرب داخله، فكانت أشبه بنبتة زُرعت في حفنة من هواء فلم تمد جذورها في شئ، لتصعد نهاية إلى بارئها (هي نظرة ابن سينا إلى النفس كما ذكرها في قصيدته العينية)، فتجد في حضرته ـ يقينا ـ الشفاء.

بقلم / محمد السيد الطناوى
وأنى المفر؟! ونظام مبارك ما زال جاثما على أنفاس الوطن ببنيته الإدارية، وهياكله الاقتصادية، وسياساته الداخلية والخارجية، ونخبته المعارضة، التي كان الرجل راضيا عنها وإن أظهرت هي السخط عليه، يحوطه غول مريع المنظر والهيئة وقد بسط أذرعه بطول البلاد وعرضها؛ غول الفساد!. ومن أسفل هذا كله جيل ناشئ يستميت في الفرار بحلمه من أي فرجة ضيقة تلوح لناظريه حتى لا يفيض ذلك الحلم تحت هذا الثقل المفزع.
فالجماعة التي آل إليها الأمر، قتلت المعنى؛ معنى الثورة، وأبقت على اللفظ كأنه قبر أو شاهد قبر يلتف المحبون حوله يبكونه في مرارة وسخط؛ فالراصد لسياسة الجماعة منذ صار الحكم إليها يدرك أنها تناولت الدولة وفق مبدأ تراثي يتلاءم وتكوينها الفكري، هو مبدأ الدولة الغنيمة؛ فليبق النظام بكامل بنيته بل وبكثير من شخوصه كما كان، ما دامت مفاتيحه قد سُلمت لهم، ولتسير عملية إبدال وإحلال لـ"عمال" النظام بـ"عمالهم" بوتيرة يدير عجلتها الظرف السياسي!. أما التغيير الجذري التي لا تعني الثورة إلا هو، وأما العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية التي ما كان سعي الحالمين ـ أولئك الذين وصلوا أرواحهم بهذه المعاني الكلية في عالم المثل، وارتضوا لها أن تهبط إلى أرض الواقع، ولو أهوى ذلك بقيمتها(1) وليقايضوا عليها بأرواحهم تلك ـ إلا ابتغاءًا لوجهها الشريف، فالجماعة ما آمنت يوما بها، وإن تجشأت ألفاظها في وجوه الآخرين صباح مساء، وليشتم عندئذ صاحب الحاسة الدقيقة رائحة كريهة؛ رائحة الأفكار المهوشة. نعم فالبنية الفكرية للإسلاميين عامة هي حامل هش لتلك المعاني (2).
أما النخبة التي نجح نظام فاشل في سطر مسارات حركاتهم لزمن طويل، فإذا به وقد حصرها داخل مربع محدد الزوايا فكانت ما بين فضائيات وصحف ومقرات أحزاب وتظاهرات سلالم. وكان لها كالصندوق الذي يطلق فيه العالِم فئرانه فإذا ما حاد أحدهم عن مسار اختاره العالِم له تدفقت في جسده شحنة كهربائية ترده عن ذلك المسار الذي أقحم نفسه فيه إلى أن يعتد الفأر الالتزام بالمسار الآمن الذي رُسم له بديا.
هذه العقول الفارغة إلا من فكرة وحيدة؛ فكرة الأنا. هذه القلوب التي شاخت كما شاخ أصحابها فألقت من بين أحمالها كل معنى نبيل عجزت عن المسير به طويلا في درب الزمان الوعر، وكان من بين تلك الأحمال المستغنى عنها الإخلاص والصدق!. هذه النخبة التي تعرت أمام الجميع مرات ومرات لكن العجز وتواضع شخوص المتصدرين من الشباب للشأن السياسي قد كساها ثوب القدرة في كل مرة!.
إذن.. من أين نبدأ؟
ونون الجمع هنا تعود على من يعيش للمعنى ممن يشتغلون بالعمل السياسي لا من يعتاش عليه، أما السؤال وإن كان ضروريا طرحه، لكن تقدمنا نحوه ينبغي أن يكون تقدمًا حذرًا، إذ السؤال يحمل في طياته غرورًا سارتريًا مضللاً، وكأن البداية رهينة إرادتنا فقط، كل ما هنالك أن نشير بإصبع تلك الإرادة على النقطة التي تبدو لنا مناسبة للبدء ليتم الأمر!،غير أن الواقع بتعقيداته يأبى أن يصدق هذا التصور، كذا الزمن (وقد ضاعف سرعة حركته ببلدنا مرات ومرات بعد أن كان يلوح لخيالنا وكأن سكتة قلبية أصابته فتوقف عن الحركة بها) فقد يغير إحداثيات تلك النقطة ما بين إشارتنا واتجاهنا نحوها.
لنؤكد بادئ ذي بدء على أن ما حبرناه أعلاه ليس مراده سكب منطقنا ممزوج بغضبنا لتندفع به الكلمات إلى عقل ووجدان القارئ، فيتفق مع صاحبها ويرى الواقع من منظوره (أو يعرض عنها إن بدا له غير ذلك)، بل هو مقدمة لنتيجة لزمت من شاركنا الرأي، وهذه النتيجة تقول بضرورة التوقف عن الحركة والاستغراق بتفكير عميق فيما مضى وفيما هو آت، فأن يظل الشباب يبذرون كل جهدهم وطاقاتهم، ويسيلون كذا دمائهم في فاعليات تتولى هذه النخبة حصد محصولها فتفسده، ثم يعاود الشباب الكرة فيعاود أولئك الإفساد، في صلف عاهرة لا حياء لها، عاهرة لا تعبأ سوى بارتفاع أسهمها في سوق البغايا، وهي في حالتنا هنا سوق الإعلام!؛ أن يدور الشباب في فلك هذا المشهد العبثي، وكأنه يخضع لإرادة خارجية تستبد بشأنه فهذا أمر لا يجيزه المنطق وتأباه المصلحة الوطنية، لكن في ذات الوقت فإن بناء أطر سياسية ـ كبديل للأطر النخبوية ـ لا يعمرها سوى الشباب أمر دونه صعوبات جمة لا يقدر عليه جلهم، هنا تبرز حالة من "شقاء الوعي" ( بتعبير المفكر المغربي محمد عابد الجابري)، وعلاجها ليس الانسحاب كليا، والارتداد إلى ما كان من عزوف آثم كرس للاستبداد والفساد، بل لتظل هذه الأطر مظلة ترد عنا ذاك الإثم، ولتكن "عزلة شعورية" تحمينا من شرورها، ولتُكَوَّن رابطة تضم الناشطين الشباب من كافة التشكيلات السياسية؛ رابطة (تجميعية) فكرية وتثقيفية بديا، يفرون إليها من فقر كياناتهم الإيديولوجي (لا شك لدي أن كافة الأحزاب على الساحة السياسية هي خلو من أي أيديولوجية صلبة وبضاعتها شعارات ليس إلا، فهذا الأمر لا تنفرد به الأحزاب الإسلامية كما يحلو لبعض خصومهم أن يدعي متبجحا)، ويعملون بها على تفريغ شعارات الثورة في قوالب فكرية صلبة ويتدارسون ملمات أحزابهم ويعضد بعضهم بعضا حتى لا تبتلعه دوامة الأطر النخبوية فتهرس مبادئهم وأخلاقهم (3)، ( فالكيانات السياسية التي لا تقوم على معتقد سياسي مُلهم تتضخم بها الذوات، فيصير الولاء للذات في ظل عدم وجود الفكرة الملهمة "ولدى تلك الذوات غير القابلة للتضخم الولاء يكون للزعيم المزيف" ، فما بالنا بمشاريع شخصية قامت بالأساس لخدمة طموح أفراد بعينهم!).
لا أتصور أن مثل هذه الرابطة ستجذب إليها "هتيفة المظاهرات" الذين افترسهم ذئب الشهرة(4)، وأنى لأمثالهم في تواضع عقولهم وبساطة ثقافتهم أن يتصدوا لهجمة ذلك الذئب المفترس، فالواحد منهم لا يدر بخلده سوى التفكير بالهتاف الذي سيهتف به في التظاهرة المقبلة أو بتدبيج تحليل سخيف يلقيه على صفحته بـ "الفيس بوك" أو على مسامع أحدهم في هذه الفضائية أو تلك، أو في بيان ينشر باسم حركته المزعومة التي لا تضم غيره وغير نفر من أصدقائه.
هذه الرابطة بحكم تكوينها وابتعادها عن الأضواء لن تجذب إليها سوى ذوي الوعي والثقافة من الناشطين، لتنمو بأولئك وتعمل على إنضاج أفكارهم ورؤاهم، وتنهض من بعدُ من أرض الخمول بعد أن تكون قد دُفنت بها لسنوات، فتميل ميلة خفيفة على تلك الأحزاب التي ستصير عندها خرائب مظلمة لا يسكنها سوى كائنات عمت بصيرتها لتتهدم، وحينذاك قد تلعب تلك الرابطة أو المنظمة (بعد ذلك) دور المنقذ بعد أن تفشل الجماعة هي الأخرى في إلباس الوطن لباسها الضيق. وهذه ليست محاولة لتشوف المستقبل بقدر ما هي قراءة للتاريخ.
(1) يرى هيجل أن الفكرة في عالم الأفكار تكون لامتناهية أو كلية وعندما تنتقل إلى أرض الواقع تصير متناهية أو جزئية.
(2)راجع مقالنا زيف مشروع "الإسلام الحضاري"
(3)لكاتب هذه السطور تجربة في أحد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي أُسست بعيد انتهاء الموجة الأولى للثورة مباشرة، وكان عضوا مؤسسا به وعضو المكتب التنفيذي لأمانة شبابه، وعاين كيف يمكن أن تُفسد هذه الأطر النخبوية على الشباب اليافع أخلاقهم ومبادئهم، والمضحك المبكي أن هذا الحزب كان يضم في برنامجه محور تحت عنوان:"دمج الأخلاق في العمل السياسي"، والذي كانت قيادات الحزب خلو منها، وانحدر بهم الحال أن باعوا الحزب مؤخرا لملياردير وقيادي اخواني شهير بثمن ليس بخسا، ولهذا الأمر حديث آخر.
(4)راجع "رحلتي الفكري في البذور والجذور والثمر، سيرة غير ذاتية غير موضوعية"، عبد الوهاب المسيري، العودة لمصر والذئاب الثلاثة.

الكاتب / محمد السيد الطناوى
إن شغلنا الشاغل في هذه الحياة هو البحث عن حلول لمشكلات تعرض لنا، وتتنوع هذه المشكلات ما بين شخصية ومجتمعية وفكرية مجردة...إلخ، وبالقطع، فكلما اتسع نطاق المشكلة أفقيا أو رأسيا كلما تطلب حلها تناولا عميقا يسبر أغوارها، فلا يعود الفرد المعني بها من تلك الأغوار إلا وقد أحكم قبضته على العناصر المكونة لها، أو هكذا يجب عليه أن يفعل. فإذا أبان لنا ذاك الفرد عن تصوره لحل المشكلة، بذكر بعض عناصرها ليغفل عن أخرى هي من لوازم الحل مع ما ذكره، لا يكون هذا الفرد بذلك قد قدم لنا جزءا من الحل أو سار بنا بضع خطوات على الطريق الصحيح، بل يكون قد ألبس علينا الحقيقة، وساقنا إلى مجاهل الشطط. أيحمل طرحنا هذا نوع من المغالاة؟.
إن طبيعة العصر المعقدة، التي يستشعرها حتى الفرد العادي في كل تفاصيل حياته، تستدعي التزام الدقة البالغة في التعامل مع أبسط شؤونه، فضلا عن أكثرها تعقيدا، إضافة إلى أن هذه الطبيعة تنبئنا على لسان علم الرياضيات بأن عصرنا ذاك قد تُحدث فيه الحركة الهينة التي لهونها نعجز عن إدراكها إذا ما تمددت في الزمان تغييرات جسيمة(1) ـ وهو ما لم تعرفه عصور ماضية ـ وبذا أصبحت الخطوة المضطربة (ونخص اهتمامنا هنا بتلك المرتبطة بالمجال الفكري موضوع طرحنا) أو المترددة أو تلك التي تنحرف عن موضعها، ولو بضع سنتيمترات، تستتبع انحرافات واسعة، لا يمكن التنبؤ بمداها.
إذن فإجابتنا على السؤال السابق ستكون بلا، وهذه الـ "لا" تقودنا إلى نتيجة تخص طرحنا الذي نزمع عرضه على القارئ الكريم وتتمثل في أن كثيرا ممن يوصفوا بكونهم علماء أو مفكرين ببلدنا هم في حقيقة الأمر مضللون لا أكثر. هم ليسوا حتى بأنصاف ولا أشباه، هم ليسوا بشيء.
وفي هذا المقال، ينصب اهتمامنا على تناول المدرسة الفكرية التي شاع تسميتها بمشروع "الإسلام الحضاري"، والذي من أبرز دعاته ببلدنا المستشار طارق البشري، والدكتور محمد عمارة، والأستاذ فهمي هويدي، والدكتور محمد سليم العوا.
الملاحظة الأولى التي تبرز لنا من استعراض خطاب هؤلاء الأعلام تتعلق بعناوين هذا الخطاب كما نجدها عند طارق البشري: "بين الإسلام والعروبة"، "الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي"، "الحوار الإسلامي العلماني"، "المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية"... أو كما نجدها عند فهمي هويدي: "الإسلام والديمقراطية"، "مواطنون لا ذميون"، "خطاب التطرف العلماني في الميزان"... أو كما تتضح عند محمد سليم العوا: "الأقباط والإسلام"، "الحق في التعبير"، "في النظام السياسي للدولة الإسلامية"... أو كما تتجلى عند محمد عمارة: "نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام"، "التراث والمستقبل"، "الجامعة الإسلامية والفكرة القومية"، "المواجهة بين الإسلام والعلمانية".
هذه هي أهم القضايا التي احتواها خطاب هؤلاء الأربعة، (الذين يمكن أن نلقبهم بالأربعة الكبار، باعتبارهم أبرز منظري مشروع "الإسلام الحضاري" وأشهرهم ببلدنا)، وإذا ما أدرنا وجوهنا، ورمينا بأبصارنا إلى الماضي، مدى يمتد إلى ما يزيد عن مئة عام، لأبصرنا ذات الإشكاليات مطروحة للنقاش، بذات المضامين، مع اختلافات يسيرة، لا تتلاءم ومرور تلك الفترة الزمنية الطويلة، التي يقف على رأسها السيد جمال الدين الأفغاني، والأستاذ الإمام محمد عبده، بل وهي هي ـ أو تكاد ـ ذات المداولات والنقاشات الفكرية التي كانت تقوم بين رواد تيارنا الإسلامي ذاك وبين رواد التيار العلماني في ذلك الوقت.
وتحت وطأة التدافع الفكري بين التيارين، اندفع رواد مشروع "الإسلام الحضاري" إلى "شرعنة" (من الشريعة) القيم التي يدعو إليها رواد التيار العلماني، وإبراز أن لا تعارض بينها وبين ما يدعو إليه الإسلام، ولا ندعي أنهم أتوا ذلك تكلفا بل لم يعدوا الحق، لكن هذه العلاقة المتشابكة - والتي استمرت إلى يومنا هذا- قد أثرت تأثيرا سالبا على اتجاه تطور هذا المشروع، وألزمته بمسار ووجهة بعينها لا يعدوها، وصرفت أصحابه عن تتبع مكامن العلل في الوجدان والعقل الإسلامي.
وكان مؤدى ذلك أيضا حالة من الاستقرار بل الركود الفكري خيمت على أصحاب هذه المدرسة، ليتقاعسوا عن التقدم نحو مسالك وعرة، أو لنقل نحو "ثقوب تاريخية" رغم جاذبيتها (أي كونها أكثر إثارة من الناحية الفكرية، وأكثر إنتاجية من الناحية الثقافية)، لكن الانجذاب نحوها بما يستتبعه من ممارسة للنقد الذاتي الصارم ربما دفعهم للاعتقاد أنه كان ليوهن قدرتهم على المواجهة الفكرية المحتدمة مع القطب الآخر (العلماني)، وحتما كان ليؤجج نيران صراع آخر مع القوى المحافظة داخل ذات الدائرة؛ الدائرة الإسلامية.
وبذا دارت جهودهم في ذات الدائرة المفرغة: الإسلام والعلمانية، الجامعة الإسلامية والجامعة العربية، الأصالة والمعاصرة، حقوق "الأقلية" وحقوق "الأغلبية"، أو بتعبير آخر الإسلام والديمقراطية... مدى يزيد على القرن من الزمان، حتى لتكاد الروائح النتنة تتصاعد من كتابات أصحاب هذه المدرسة المعاصرين، لتضيق صدورنا، بهذه العملية الاجترارية !.
وإذا كنا نستطيع أن نلتمس العذر للرواد الأول لهذا التيار الذين حاولوا على عجل أن يستعيدوا التوازن لأمتهم ـ إثر هجوم شامل لا يعرف الهوادة من قبل الغرب الإمبريالي ـ عبر "شرعنة" قيم الحداثة، ودمجها في المنظومة الثقافية الإسلامية، (وبخاصة وأن الرائدين الأفغاني وعبده قد ضمهما النضال ضد قوى الاستعمار وقوى الاستبداد الداخلي ضمة لم يستطيعا الفكاك منها)، لكن ورثة هذه المدرسة الذين أتيحت لهم فرصة المراجعة ومعالجة ما أصاب الوجدان والعقل الإسلامي من تشوهات خطيرة لم يتقدموا خطوة واحدة على هذا المسار، واندفعت أقلامهم مرغية مزبدة عن ذات الموضوعات التي تناولها الرواد ومن لف لفهم في زمانهم لتضيف إليها الحواشي ويفصلوا ما جاء مجملا بها (وهذا مما يدعو للسخرية فقد دأب أرباب ذلك المشروع على نقد علماء عصور الانحطاط بأنهم لم يقدموا إضافات حقيقية، واكتفوا بإضافة الحواشي على المتون!).
أهو الجبن الفكري وطلب السلامة؟. نعم ربما كان هو ذاك، فالعمل الحفري المعرفي يلزمه شجاعة فائقة (فضلا عن القدرة) من المؤكد أنها لا تتوافر لتلك العقول "السكولاستيكية"(2).
وعلى هذا لم يتقدم ذلك المشروع خطوات ذا قيمة على أي مسار، فلا هو خطى خطوات ملموسة تجاه الهدف الأسمى له (النهضة)، ولا هو استطاع أن يحقق الجماهيرية التي أفرزها الخطاب الإسلامي المتشدد (لا شك أن أحد أهم أسباب ازدهار هذا الخطاب انعدام فكر نقدي حول التراث الديني)، ولا هو ساهم في علاج التشوهات التي ألمت بالعقل والوجدان الإسلامي! (ما الذي حققه؟!!).
ولنخطو الآن خطوة جديدة فنكشف عن أحد تلك "الثقوب التاريخية"، التي ندعي أن الإعراض عن استكشافها، واستعراض أحشائها ـ بأدوات تقدمها لنا المناهج العلمية الحديثة ـ قد أبقى على التشوهات التي لحقت بالعقل والوجدان الإسلامي قائمة، وليحول ذلك بين تجسد قيم الدين الحق (الصالح لكل زمان ومكان كما ندعي ونؤمن) في الأمة، أنتمادى فنقر ـ مستعيرين تعبير أحد المفكرين الغربيين في وصفه للتاريخ المسيحي ـ أن تاريخ الإسلام ـ نتيجة لتمكن هذه التشوهات من جسد الأمة ـ لم يكن سوى سلسلة خيانات متكررة للإسلام؟! (الوحيد الذي كانت لديه الجرأة الفكرية ليصل إلى تلك النتيجة، دون أن يتعرض لأسبابها، هو المغفور له سيد قطب). ولعل أبرز هذه "الثقوب التاريخية" بل في المقدمة منها، تلك الوقائع التاريخية المسماة ب"الفتنة الكبرى".
لنشر بداية وقبل أن ينجذب القلم تجاه هذا "الثقب التاريخي" ـ مكتفين بتسليط ضوء خافت على غوره العميق ـ أن دعوتنا ـ في لفت الانتباه إلى ضرورة التنقيب بتلك الفترة الزمنية ـ لا تتشابه وتلك الدعاوي التي تبرز بين الحين والآخر منادية بإعادة قراءة التاريخ الإسلامي. لا، بل هي أكبر وأوسع نطاقا من تلكم بكثير، هي أشبه بدعوة لاختيار موطن ايكولوجي جديد يجنب الأجيال القادمة تلك الصورة التي يمكن تمثيلها بالحالة المعروفة باسم "القتامة الصناعية"(3)، وقد صبغت سلاسل جيلية إسلامية كاملة.
يقدم لنا واحد من أهم منظري التاريخ الغربي المعاصر إدوارد هـ.كار فرضية تشير إلى أن "القول بأحداث أو وقائع تاريخية مستقلة عن سياق تفسيري أو حبكة مفترضة هو مغالطة شديدة الادعاء"، وتسلط هذه المقولة الضوء على إشكالية المعرفة التاريخية، لتحثنا على ضرورة التناول النقدي للتاريخ، أو بتعبير أدق، التناول النقدي لـ"الحبكة" التاريخية، وهو أمر نراه ضرورة لا غناء عنها في تناول الحقبة التي نحن بصدد التعرض لها ـ أو غيرها بطبيعة الحال ـ فهذه الفترة ـ الفارقة والثرية بالأحداث ـ مازلت فاعلة بدرجة كبيرة إلى وقتنا الحاضر، وربما لن يسمح مقامنا هنا سوى بمس جانب هام من جوانب هذه الفاعلية مسا رفيقا، يتعلق بالفرضية التي نُعنى بطرحها على القارئ الكريم، وتقول بأن "الحبكة" التاريخية التي رفع راياتها مفكرو أهل السنة المعتمدين عن تلك الفترة الزمنية المحورية كانت تقضي بانطفاء نجم الإسلام المشع (لكن نوره ـ مع ذلك ـ سار بين الأفلاك لم يعره زوال)، وبتعبير آخر لقد هوت مطرقتهم التاريخية فوق العديد من القيم المطلقة التي ثبتت أوتادها التجربة النبوية وكذلك تجربة الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، لتؤثر هذا الفعل الغاشم على أن تمس التبجيل والتعظيم الواقع بين جنباتها لصحابة رسولنا الكريم. وبعبارة ثالثة ـ وموجزة ـ انتصروا للمرجعية التاريخية (لصحابة الرسول) على حساب المرجعية المفارقة.
لقد امتطى بعض رواة "الفتنة" صهوة تلك العاصفة العاتية، لتهب على أبناء الأمة الإسلامية، وتقذف بهم إلى سبيل لم تمهده قيمهم التي ورثوها، وهنا مضوا يتخبطون على غير هدى، فالدين الذي تبدى أول ما تبدى كثورة اجتماعية، تعصف بكل مظاهر الظلم الواقعة على المستضعفين والفقراء، ليطوي نفوسهم، وينطلق بها إلى أعال لم يخبروها يوما، فيسلموا له القياد، ويهبوا في سبيله الحيوات، هذا الدين تنكر لنسلهم، حتى "شاع لدى المتأخرين من أهل الفقه: أن لا حق في المال سوى الزكاة، وأصبح هذا كالقضية المسلمة عند كثير من المشتغلين بالعلم الديني"(4)،(والواقع أن هذا كان الاتجاه الأشهر والسائد على طول التاريخ الإسلامي رغم عظم القامات التي تبنت الرأي المخالف لذلك فمن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي ذر وابن عمر وغيرهم، ومن التابعين مجاهد بن جبر، وطاووس بن كيسان...، وفقهاء أمثال الشعبي وابن حزم...، ومن الرموز الإسلامية في العصر الحديث جمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي). وليذل أهله على مدار قرون مديدة، تحت وطأة حكم أن لا يجوز الخروج عن الحاكم، وإن طغا وإن فسد....وإن جلد ظهرك وأخذ مالك...، وهو هو الدين الذي رفع رسوله الكريم ـ في زمن كسرى وقيصر ـ راية الشورى خفاقة سامقة، ونادى خليفته الأول في الناس أن قوموني إذا رأيتم مني اعوجاجا، وحمد خليفته الثاني ربه أن كان بين رعيته من إذا اعوج هو عن الطريق المستقيم قومه بسيفه !. وإن كان ذلك كذلك، فلتنحدر جماهير المسلمين عليلة نحو مطارح لقمة العيش التي تتساقط من موائد أغنيائهم، ولتغلي مراجلهم ـ دوما ـ بسفاسف الأشياء، وتوافه الأمور!، وليُقبر كل صوت ثائر حاول أن يتملص من كهوف الصمت ليتردد دوي صوته في الوديان الفسيحة !
إذن فالآفات التي حملتها "الحبكة" التاريخية السنية الرسمية (بما احتوته من انتقاء وحذف وتنظيم وتعظيم أحداث صغيرة وتصغير أخرى عظيمة) لوقائع "الفتنة" قد أصابت اللاوعي الجمعي لدى الأمة بأمراض جد خطيرة، إذ خلخلت البناء القيمي الإسلامي، وأرست قيم الاستبداد داخل هذا اللاوعي بالموازاة مع إرسائها في واقع الأمة الحياتي، ووطأت كذلك لنظام رأسمالي بغيض أضحى ك"القضية المسلمة عند كثير من المشتغلين بالعلم الديني" ، لتطبق أجفانها ـ بعد ذلك ـ في خشوع وورع وتتمتم قائلة: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا!!.
وهاهنا يحسن بنا شيء من التفصيل نسوقه للقارئ: إن الرهبة التي شلت أقلام مؤرخو "الحبكة" السنية الرسمية لوقائع الفتنة عن الإدانة الصريحة لأفعال عثمان (رضي الله عنه)(5) بل واجتهدت في تبريرها (ولاشك أن في هذا انتصارا للتوجهات المشار إليها سلفا، والتي تعمقت في عهد معاوية، لتواصل "الحبكة" الرسمية نصرتها لها)، ولم تدن كذلك الصحابة الذين حرضوا عليه( بل ربما لم تعترف بذلك)، ولم تدن أيضا أولئك الذين اعتزلوا وتركوه يلاقي مصيره، لكنها أدانت بقسوة شديدة الخارجين على عثمان (من غير الصحابة)، ولم تلمح في خروجهم سوى أنه مؤامرة نسج خيوطها ابن سبأ، الذي رأى البعض أنه ليس سوى خرافة مبتذلة روج لها مؤرخو "الحبكة" الرسمية لسد ثغرات روايتهم، أو أن كاهله ـ إن كان له وجود ـ قد أثقل بما لا يقدر مثله أن يصمد له.
المدهش بعد ذلك أن تلك "الحبكة" وإن كانت أوغلت في إدانة الخارجين على عثمان، فقد تباطأت بل انصرفت عن إدانة الصحابة الخارجين على الإمام علي، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص الذين خرجوا عليه بزعم الثأر لنفس واحدة ليزهق في حربمهما ضد الإمام سبعون ألف نفس!!، وبعد أن يستتب الأمر لمعاوية يتناسى هذا الثأر، ثم يورث الحكم لابنه بعد ذلك بحد السيف!!.
وقد وقر بذلك في اللاوعي الجمعي لدى الأمة أن القيم الإسلامية ليست مطلقة، وأنها قبل أن تشد قوسها تفتح عيناها العمياوان ـ أو هكذا يفترض أن يكونا ـ لتبصر من تصيب!. وقد قطعت تلك "الحبكة" ـ ولا نقول الأحداث ذاتها ـ الشرايين التي تغذي قيم الشورى ومرجعية الأمة أو على الأقل أوهنتها، ولتشدد وثاق الأمة إثر ذلك، وتقدمها قربانا إلى حكامها الطغاة ومحيطهم من فقهاء السلطان والأغنياء العتاة، ليسيسها الأولون على القتات من فضلات الأخيرين وصدقاتهم، هذا إن تفضلوا وتصدقوا، (ولعل التنظيمات الإسلامية بمجتمعنا أصدق دليل على ما ألم بالعقل والوجدان الإسلامي من تشوهات عميقة، فمن تميع للقيم وتوقف عند حد الإقرار الشكلي لها، إلى ميكافيلية تتسلط بقوة على ممارساتهم السياسية، إلى توجه رأسمالي بغيض يحكم رؤاهم الاقتصادية، إلى تغليب ـ في الشأن العام ـ سفاسف الأمور على عظائمها)!.
لنستعيد دعوانا التي قدمنا بها مقالنا، ومؤداها أن الإقدام على تفسير مشكلة علمية أو فكرية يتطلب بداية أن نصل إلى أبعد نقطة تعوزها المعالجة الجادة لموضوع البحث أو المشكلة، كذلك يُشترط إحكام عرض حزمة العناصر التي تتشكل منها المشكلة موضوع البحث، وإلا نجم عن عدم مراعاة ذلك اضطرابات (فكرية) جسيمة (كما أوضحنا أعلاه). ولاشك أن المشروع المزعوم لم تلامس قدماه تلك المساحات التي كان حتما عليه أن يتقدم إليها، وإن تقدم أحد حملته نحو أي منها نرقبه يدور حولها، ولعله يلامس أطرافها، ثم يبتعد آخرا. فلا وجود لحفريات نقدية ـ ضمن هذا المشروع ـ تنصب على ما أسميناه ب"الثقوب التاريخية" (وقد المحنا ـ على عجل ـ وبإيجاز شديد لنموذج لها، وأشرنا سريعا إلى الآثار المترتبة على خلوه منها) إنما قوامه عملية اجترارية تتسبب في شلل عقلي مؤلم للقارئ، وليورث مرور الزمان بذلك حلوقنا علقما يهرسها، ومرارة تسد منافذ أنفاسنا.
نحن أمام أناس يدعون أنهم أرباب مدرسة للإصلاح والتجديد، لكن الواقع ـ كما بيناه ـ يهزأ بادعائهم ذاك، فمبلغ جهدهم لا يعدو كونه "شرعنة" أو "أسلمة" لقيم الحداثة، أي عملية طلاء سطحية، لا تتضمن معالجة حقيقية لموانع تطور القيم التي بذرها الإسلام في مرحلة جد مبكرة ـ وكانت لتثمر رؤية قيمية أصيلة متكاملة تغنينا عن سواها ـ وهذه المعالجة كانت لتستتبع ـ بطبيعة الحال ـ ترسيخ القيم المبتغاة داخل اللاوعي الجمعي لدى الأمة ـ كذا الوعي ـ رسوخا صلبا متينا، وبذا تتقدم الأمة تقدما واثق الخطى مطمئنا لبناء صرح النهضة.
أما وإن ذلك لم يتخذ سبيله إلى الواقع ـ إضافة إلى ما ذكرنا أعلاه ـ فليستحق هؤلاء بهذا توصفينا السالف ذكره بأنهم مضللون لا أكثر. هم ليسوا حتى بأنصاف ولا أشباه، هم ليسوا بشئ.
وإن لهب الحقيقة ليتعالى مشمئزا من هذه العقول المائعة (القديمة والمعاصرة) التي زيفت الوعي الإسلامي، وإن ينبوعها ليأبى أن يروي عطش تلك العقول المدنس إليه، ولعل عواصفها التي هبت على بلدنا مع ثورة مباركة تجرف في هبوبها كل سموم تكون قد نفثتها تلك العقول المائعة في أجواء أمتنا لتصفو قيمنا ومثلنا، فتشرئب إليها النفوس والأفئدة بالتعظيم الواجب والمحبة الخالصة والطاعة الصادقة.
(1) هي نظرية تعرف باسم" تأثير الفراشة "، تفيد بأن أي فعل وإن بدا بسيطا هينا في الظاهر فإن له تأثير، وقد يتطور هذا التأثير تطوراً هائلاً غير متوقع، حيث أن "رفرفة جناح فراشة في البرزيل قد تفجر عاصفة في تكساس"، وقد أطلق الباحث الأمريكي "فيليب ميريليس" هذه التسمية "تأثير الفراشة" لتوصيف تلك الحالة، معتمدا في إطلاق نظريته هذه على أبحاث عالم الرياضيات والأرصاد الجوية "إدوارد لورينز".
(2) مصطلح لعالم الاجتماع الفرنسي الشهير "بيير بورديو" يصف به العقل التكراري الاجتراري.
(3) "القتامة الصناعية": حالة تصف اختلال جيني أدى إلى تطوير سلالات داكنة من الفراشات نتيجة تكيفها مع التلوث الصناعي (في إنجلترا).
(4) فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، الجزء الثاني، ص963
(5) فمن توليته شقيقه من أمه الوليد بن عقبة عاملا على الكوفة بدلا عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه)، وهو من وصفه القرآن بصفة فاسق، أي في النسق القرآني الرجل الذي لا يوثق بكلامه ( أنساب الأشراف،ج5،ص30،البلاذري، دار المعارف)، وتبع هذا التعيين بعام الحاق عبدالله بن أبي سرح، ابن عم عثمان وشقيقه بالرضاعة بولاية مصر ـ بديلا عن عمرو بن العاص ـ وهو الذي أهدر النبي دمه إثر إدعاءه قدرة على الإتيان بآيات محكمات على غرار آيات القرآن الكريم، وعين ـ كذلك ـ أمويا آخرا، ابن خاله عبد الله بن عامر على البصرة بدلا من أبي موسى الأشعري. وعفا عن الحكم بن أبي العاص الذي كان الحكم بن أبي العاص كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجاهلية ، وكان أشد جيرانه أذى له في الإسلام ، وروي انه بعد إسلامه وقدومه المدينة، اعتاد أن يهزأ بالرسول، واطلع على رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو في بعض حجر نسائه فعرفه وخرج إليه بعنزة وقال : من عذيري من هذا الوزغة اللعين ، ثم قال : لا يساكنني ولا ولده فغربهم جميعا إلى الطائف، ومن هنا كان نفيه إلى الطائف، ورفض أبو بكر ولا عمر طلب ردهم إلى الدينة (أنساب الأشراف،ج5، ص27)، وأوغل عثمان (رضي الله عنه) في سياسة محاباة أقاربه من بني أمية، فوهب ابن عمه عبدالله بن أبي سرح خمس غنائم أفريقية ثم عاد واستردها منه بعد غضبة الصحابة، ومنح صدقات قضاعة لعمه الحكم"، إضافة إلى اعتماده سياسة الاقتراض من بيت المال، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم ثروات طائلة لدى الكثيرين. هذه السياسات وغيرها هي التي أضرمت نيران غضب لدى كثير من الصحابة، فكان الصحابيان محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر (وهما من الصحابة الذين اشتركوا في حصار عثمان، ومنهم كذلك ابن عديس، وعمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم) عام خروجهما مع عبد الله بن سعد بغزوة الصواري يظهران عيب عثمان وما غير وما خالف به أبا بكر وعمر، وأن دم عثمان حلال. ويقولان استعمل عبد الله بن سعد؛ رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح دمه ونزل القرآن بكفره، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وأدخلهم، ونزع أصحاب رسول الله واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر.(تاريخ الطبري، ج4، ص291، دار المعارف)، وكان عمرو بن العاص يقول: والله إن كنت لألقي الراعي فأحرضه عليه (على عثمان)، كذلك أم المؤمنين عائشة، التي ذهبت إلى أبعد من هذا فخرجت على الناس قابضة على شعر النبي ونعليه، معلنة لهم، أن سنة نبيهم قد تركت بعدهم)، وكانت تنادي في الناس:"اقتلوا نعثلا فقد كفر"(تاريخ الطبري، ج4، ص495)، وكان الصحابي عمار بن ياسر من أبرز المعترضين على سياسة عثمان، فجرى القبض عليه والتنكيل به بشدة(أنساب الأشراف،ج5،ص48)، كما لم يكن من أصحاب النبي (ص) أشد عليه من طلحة (الأنساب، الجزء الخامس، ص81) أما علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) فلم يألو جهدا في مراجعة عثمان (رضي الله عنه)، المرة تلو المرة، وكان أن دخل عليه بعد اجتمع الناس عنده واشتكوا له، فقال: الناس ورائي، وقد كلموني فيك، والله ما أدري ما أقول لك، وما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على شئ لا تعرفه.....وإني أحذرك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول، فإنه يقال: يقتل في هذه الأمة إمام، فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويتركهم شيعا، فلا يبصرون الحق لعلو الباطل، يموجون فيه موجا.....". (تاريخ الطبري،ج4، ص337)، وكانت آخراها، أن دخل عليه مغضبا، قائلا له: أما رضيت من مروان ولا رضى عنك إلا بتحرفك عن دينك وعن عقلك، مثل جمل الظعينة يقاد حيث يسار به.... وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك، أذهبت شرفك، وغلبت على أمرك".(تاريخ الطبري،ج4، ص362)


بقلم / محمد الدسوقى رشدى

لم أكن أرى في دعوة مقاطعة الانتخابات ـ قبل إجرائها ـ سوى أنها دعوة خرقاء، يتجاهل مطلقوها كل مفردات الواقع، والتي تتمثل في أن أيا من مرشحي الرئاسة البارزين لم يبدوا أي نية للمقاطعة رغم كل العيوب التي شابت شروط وضوابط العملية الانتخابية، كذلك فإنفاذ الانتخابات التشريعية بقدر كبير من النزاهة ودون أي تدخل فج في سيرها كان ليحول دون تبني الجماهير لتلك الدعوة، وفي ذات الوقت فقد كان المعلوم من الواقع بالضرورة يشير إلى أن هذه الانتخابات سيجري تزويرها، فالمجلس العسكري ـ على طول الفترة الانتقالية ـ أثبت بما لا يدع مجالا للشك رغبته في البقاء بالسلطة، وهذا الأمر ليس مرتبط فقط برغبة أفراده بتأمين أنفسهم من أي ملاحقة قضائية، ربما تطاردهم في المستقبل، بسبب ما هو معلوم للكافة من جرائم قد ارتكبت في حق الثوار بعيد الموجة الأولى للثورة، وما هو غير معلوم للكافة ـ بعدُ ـ من فساد قد مورس ـ من قبلهم ـ طوال العهد السابق على الثورة، بل والمحافظة ـ أيضا ـ على ما تمخض عن هذا الفساد من ثروات متضخمة، بدأت تفوح روائحها العطنة عبر تقارير صحفية نشرت مؤخرا.
ورغم أن الطرفين من دعا للمقاطعة ومن رفض الدعوة، كانا واعين لذلك، غير أن كلاهما لم يكن ليتوقع أن يجري التزوير بهذه النعومة، فالسيناريو الذي حلق في عقول غالبية النشطاء والمحللين السياسيين هو تزوير فج خشن يؤمن ظهيرا شعبيا لأي تحرك في الشارع مستقبلا، لكن المُخرج الذي أدار الفترة الماضية بكثير من البراعة لم يفقد لمسته البارعة تلك وهو يضع مشهد النهاية.
وبإعلان نتيجة الانتخابات رسميا وقد تقرر إجراء جولة الإعادة بين مرسي وشفيق يصبح من الحمق إضفاء الشرعية ـ وقد ثبت لدينا تزوير الجولة الأولى ـ على الجولة الثانية، وبخاصة وأن الدكتور محمد مرسي ليس هو المرشح الأمثل الذي يمكن أن تلتف حوله الجماهير لتجابه معه ما سوف يقع من تزوير، بل هو المرشح الأمثل لتمرير الجنرال شفيق بأقل الخسائر الممكنة، ولا أعتقد أن جلسات المقايضة ـ عذرا ـ الرخيصة التي تجري الآن بين القوى السياسية وجماعة الإخوان الملسمين بفرض نجاحها، يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا ـ أو صغيرا ـ على أرض الواقع.
لذا فالمقاطعة ـ وبخاصة أن الإخوان لن ينكصوا عن سعيهم المحموم الطامع وغير العاقل وسيذهبوا إلى جولة الإعادة ـ ليس كما يردد البعض من أنها ستصب في صالح مرشح العسكر، بل إن إدلائك بصوتك لمرشح الإخوان هو الذي سوف يترجم عمليا لصالح الأول، إذ باشتراكك في عملية التصويت تكون قد استسلمت لنتيجة تلك الانتخابات الملفقة، واعترفت ضمنيا بنزاهتها، فإذا ما تكرر الأمر بجولة الإعادة ـ وسوف يتكرر ـ يكون موقفك شديد الضعف إن قمت بأي أعمال احتجاجية.
أظن أنه لم يعد أمامنا الآن سوى الدعوة بقوة إلى النزول مرة أخرى إلى الشارع، وأعتقد أن على السيدين الفاضلين أبو الفتوح وصباحي أن يكفرا عن خطيئتهما التي ارتكباها بإصرارهما على الترشح كلٌ بمفرده بأن يتقدما الجماهير إلى الشارع.
إن المعادلة التي غفلت أو على الأحرى تغافلت عنها نخبتنا الفاشلة وتحكمت في علاقة الثورة بالمجلس العسكري منذ البداية هي "كل شئ أو لا شئ"، والآن لم يعد هناك منفذ آخر سوى إنفاذ تلك المعادلة إلى أرض الواقع.

الكاتب / محمد السيد الطناوى
متفاؤل رغم علمي أن الإخوان سيُقبلوا على خوض جولة الإعادة متجاهلين كل ما قيل ويقال عن تزوير الانتخابات، يدفعهم طمعهم غير العاقل، ليلعبوا بذلك دور المحلل لزواج العسكر بالدولة.
متفاؤل رغم علمي بأن محاولات التوافق التي يجري الحديث عنها الآن لن يكتب لها النجاح، فحديث إعلاء المصلحة الوطنية يخفي وراءه أطماع نخبة على استعداد دوما لأن تأكل ـ بلا أدنى قدر من حياء ـ بأثداء الوطن، وسيكون على جماعة الإخوان أن تطعم تلك الأفواه الفاغرة مما تحصلت عليه، وبذلت في سبيله الغالي والنفيس، وسلكت من أجله كافة السبل، مشروعة وغير مشروعة، وهذه الأفواه من الكثرة والنهم بحيث يصعب إرضاؤها، حتى وإن عُقد هذا التوافق بين القوى السياسية فسيكون هشا، قابلا للكسر في أي وقت، يتربص أطرافه ببعضهم البعض، كذلك لن يكون ملزما للجماهير.
أما عن أسباب تفاؤلي هذا:
** أن هذا الحدث العظيم والاستثنائي في تاريخنا وتاريخ العالم أجمع لا يمكن أن يكون حادثا عرضيا، يستوقف اهتمامنا برهة لنتجاوزه بعدها وكأن شيئا لم يكن. لا التاريخ يفيد بأن حدثا بهذا الحجم يمكن أن يتمثل هذه الصورة العبثية، ولا إيماننا بالله تعالى يجعلنا نعتقد في حدوث ذلك.
** لربما شاء المولى عز وجل أن تظل جذوة الثورة مشتعلة لكي يحترق بنيرانها سياسيو العهد البائد (أو بالأحرى الذي نأمل أن يبيد) أولئك الذن لم يتوقفوا يوما عن ممارسة عهرهم حتى في زمن الثورة، ويُنضج أوارها كذلك جيل من الشباب استحق أن يتقدم ليتسلم لواء القيادة (لكن هناك بينهم من لم ينضج بعد بدرجة كافية، فعندما كان حكيم الثورة البرادعي يحادثنا عن تساقط الأقنعة وكشف المتلونين وجدنا بعض هؤلاء يصفق بحماسة للمقنع المتلون!، ورغم أن هناك أمثلة عديدة يمكن أن أسوقها للتدليل على عدم النضج المشار إليه، لكني أثرت ضرب هذا المثال، أذ اعتقد أن أهم المعارك التي علينا خوضها معركة إزاحة تلك النخبة الفاشلة (والفاسدة أخلاقيا) عن مواقع القيادة)، وربما كان فوز أحد مرشحي الثورة، لتنقضي بذلك مرحلتها الأولى كان ليساعد على إعادة إنتاج نظام مبارك الذي يعتمده هؤلاء داخل كياناتهم الصغيرة، وبخاصة وهم إلى اليوم المتصدرون للمشهد السياسي.
لذا "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". صدق الله العظيم

الكاتب : محمد السيد الطناوى

إن ما ظهر حتى الآن من بواطن حياتنا السياسية ـ من سلبياتها تحديدا ـ ليس سوى عارضا من عوارض ما كتم ـ منها ـ حتى الآن، ولسوف تشهد الفترة القادمة طفو كل ما علق في تلك الأعماق. وهذه ليست دعوة للتشاؤم، إذ ما سيطفو هو الزبد، ليذهب جفاءا أما ما ينفع الناس فسيمكث في بلدنا بإذن الله تعالى.
قد علقنا مع مجلس عسكري لم يخض بعد معركته الوجودية، التي يأمل أن يكون مغنمه منها، تأمين نفسه أولا من أي ملاحقة قضائية، ربما تطارد أفراده في المستقبل، بسبب ما هو معلوم للكافة من جرائم قد ارتكبت في حق الثوار بعيد الموجة الأولى للثورة، وما هو غير معلوم للكافة ـ بعدُ ـ من فساد قد مورس ـ من قبلهم ـ طوال العهد السابق على الثورة، ثانيا المحافظة على ما تمخض عن هذا الفساد من ثروات متضخمة، بدأت تفوح روائحها العطنة عبر تقارير صحفية نشرت مؤخرا، يلي ذلك ـ في ترتيب المغانم التي يأمل المجلس أن يتحصل عليها ـ الحفاظ على وضعية المؤسسة العسكرية وامتيازاتها، كخط تأمين ثان لهؤلاء.

إذن ستكون هذه المعركة ـ وهي مرتبطة بموقعة الرئاسة لا شك ـ الأبرز والأكثر شراسة بين كل المعارك التي خاضتها الثورة طوال الفترة الماضية، لكنها لن تكون الأخيرة. ستكون الفاصلة ـ نظريا ـ بين عصر وآخر، لكن ليس بالضرورة أن تعقد قطيعة مع العهد الذي نأمل أن يبيد.
وقد ابتلانا القدر بنخبة لم تستحق القيادة يوما، وإن رفعت لواءها طويلا. جل هم أفرادها تسويق ذواتهم المتضخمة على حساب أفكارهم ورؤاهم الضامرة. لم يملكوا يوما سوى أقلاما تنفيسية، وألسنة "حنجورية" يلوونها بأحاديث فارغة أو يتبارزون بها على "المصاطب الفضائية" (برامج التوك شو)، وإزاحتهم عن مواقع القيادة هي معركة مؤجلة.
وقد شاءت عبقرية رجل تخليق جماعة هي عند أبناءها الوطن. فهذا المفهوم؛ مفهوم الوطن لا وجود له في أدبياتها، وبديله، مفهوم "الأمة"، غير متعين على أرض الواقع، لذا فالجماعة هي الأمة والوطن معا، وويل لنا إذا ما اشتبكت ـ مجددا ـ مصلحة الجماعة ـ بحجمها الكبير الذي هي عليه اليوم ـ مع مصلحة الوطن! (لعل اللحظة النماذجية لهذا الاشتباك بين المصلحتين قد وقعت أثناء الموجة الأولى للثورة، وتمثلت في الصفقة التي عقدت مع عمر سليمان ـ وأزاح الستار عنها عديدون، منهم القيادي السابق بالجماعة م.هيثم أبو خليل ـ وحاول الإخوان إتمامها عن طريق إخلاء الميدان من عناصرهم، غير أن المولى المقتدر الرحيم قد سلم)، وأشك أن قياداتها لن يهدأ لها بال إلا بعد أن تُلبس الوطن لباس الجماعة الضيق، أو يتمزق، ليذهب ريحها إلى الأبد. .
وقد تراصت عقول قاصرة جامدة لتشكل تيار سلفي ألقى بظله المستطيل على الساحة السياسية. ولجها ـ مؤخرا ـ برؤى ومقولات ومصطلحات وفقه و زي ينتمي إلى الماضوية، وهذه الماضوية ستُقبل ـ حتما ـ على خوض معركة مع الحاضر والمستقبل، وهي في اعتقادي لن تكون معركة عنيفة، إذ لن تعدو كونها مناوشات و شد وجذب، شد ـ للوطن ـ من قبل هؤلاء إلى ماضويتهم، وجذب ـ للوطن ـ من قبل التيار الرئيسي بالمجتمع إلى المعاصرة، وستقل حدة وعنف الشد والجذب بالموازاة مع زيادة فاعلية التيار الرئيسي في الحياة السياسية.
لهذا كله أقول أن ما ظهر حتى الآن من بواطن حياتنا السياسية ليس.سوى عارضا من عوارض ما كتم ـ منها ـ حتى الآن
بقلم
الكاتب / محمد السيد الطناوى
