
وصل الغضب فى مصر إلى أقصى الحدود منذ سنوات، وكنت – أنا وغيرى – نشير إلى ذلك فى شتى كتاباتنا، ولكن بعد نجاح ثورة تونس فى منتصف يناير ٢٠١١، تغير الوضع، وأصبح التغيير أقرب مما نتصور، على الأقل فى نظرى.
لقد وصل المصريون إلى درجة من درجات اليأس المطبق، وفقدوا الثقة فى كل شىء جميل، وفى أى غد مشرق، والأهم من ذلك أنهم فقدوا الثقة فى أنفسهم، فأصبحوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مجموعة من «السكّان»، وليسوا شعبا عريقا عظيما.
وبسبب هذا اليأس، تعامل البعض مع الدعوة التى خرجت إلى التظاهر فى عيد الشرطة الذى يوافق ٢٥ يناير ٢٠١١ بشكل روتينى، فقالوا إنها ستكون مناسبة مثل كل المناسبات، وإن المبالغة فى تصويرها وكأنها ثورة محددة الموعد يعتبر تسطيحا لأمر شديد الأهمية!
لذلك هاتفت بعض الناشطين لكى يغيروا نظرتهم لهذه المناسبة، وكانت حجتى فى ذلك أن ما حدث فى تونس جعل الملايين من المصريين يصدقون أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن هناك احتمالا أن نرى مفاجأة كبيرة فى هذا اليوم، وقد استجاب لى أغلب الناشطين الذين حدثتهم، وقرروا إعادة النظر فى المشاركة فى هذا اليوم.
قررت أن أشترك فى هذا اليوم مع مجموعة من خيرة شباب مصر يمثلون «الحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغيير»، تلك الحركة الشبابية النقية التى شرفت بالمشاركة فى تأسيسها، وشرفت بأن أكون منسقها العام لعام كامل انتهى فى ديسمبر ٢٠١٠، وقد اختار الشباب أن يقيموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء «دار الحكمة»، وكان الترتيب يقتضى بأن يكون المكان سرياً، لذلك لم أعلم بمكان التجمع إلا قبل الوقفة بحوالى ساعة، وقد أخبرت عشرات الناشطين الذين أرادوا أن ينضموا لهذه الوقفة أن يتصلوا بى صباح الثلاثاء ٢٥ يناير لكى أخبرهم بمكان الوقفة.
هذا التخطيط نتج عنه أننا حين وصلنا إلى نقابة الأطباء لم نجد أى شرطة، بل وجدنا المكان خاليا لنا تماما، مما أتاح لنا فرصة التجمع، وتكوين نواة لمظاهرة كبيرة، وبالفعل.. تكونت هذه النواة من عدة مئات، ثم استمرت فى التضخم حتى بلغت ما يقرب من حوالى ألفى متظاهر، غالبيتهم العظمى من الشباب، بنين وبنات.
بعد أن بدأنا بالهتاف حضرت الشرطة، وقامت بعمل كردون أمنى (محترم) من حولنا، بل إنهم أغلقوا حركة سير السيارات فى شارع قصر العينى.
بدأت الهتافات: «عيش، حرية، كرامة إنسانية».. وأنا ابتكرت هتافين، الأول: «يا أهالينا انضموا لينا، قبل بلدنا ما تغرق بينا»، والثانى: «يا عسكرى يا أبوبندقية، إنت معايا ولاَّ علىّ، إنت بتحمى فى الحرامية»! وهو هتاف مقتبس من أغنية كتبها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح. وكنت أنظر فى عيون المجندين والضباط، خصوصا عند جملة: انت بتحمى فى الحرامية، فأرى فى عيونهم حزنا وخجلا يصل لدرجة الخزى...!
حضر الوقفة مجموعة من الرموز والمثقفين، من أهمهم د. عبدالمنعم أبوالفتوح، والكاتب الساخر بلال فضل، والسيناريست محمد دياب، والمخرج عمرو سلامة، والمطرب المتميز حمزة نمرة، وغيرهم .
كانت الهتافات مركزية، يقودها الناشط محمود عادل، مؤسس جروب «البرادعى رئيسا».
ثم بدأنا بإلقاء الكلمات: بدأت أنا، وكانت الكلمة فى أغلبها موجهة إلى هؤلاء الزبانية الأغبياء الواقفين أمامنا، يحمون قاتلَهُم، من مخلِّصِهم!
ثم توالت الكلمات، عبدالمنعم أبوالفتوح، وبلال فضل، الذى ألقى كلمة شديدة التأثير.
بعد مرور ما يقرب من ساعتين اتضح أننا أصبحنا فى فخ، فلا نحن نستطيع الحركة، لأن الحصار الأمنى كبير جدا، ولا حتى نستطيع أن نزيد حجم المظاهرة، وذلك بسبب منع الناس من السير فى الشارع سواء بسياراتهم، أو راجلين!
وبدأت تصلنا أخبار من أماكن شتى، كلها تشير إلى أن آلاف المتظاهرين يزحفون من أماكن مختلفة إلى ميدان التحرير، لذلك اقترحت أن نكسر الطوق الأمنى ونتجه إلى الميدان، وكان ذلك قرارا صعبا، لأننا نرى أمامنا جنودا مدججين بالسلاح والغباء، جاهزين للفتك بنا إن حاولنا التحرك.
فى النهاية، بدأت – أنا وغيرى – ممن نفد صبرهم من هذا الوضع المتجمد بكسر الحصار، وكانت النتيجة أننا اشتبكنا مع الأمن، وحدثت بعض الإصابات، وحين انكسر الطوق جرى الجميع باتجاه ميدان التحرير.
وكان من أهم الأشخاص الذين أصيبوا المخرج السنيمائى عمر سلامة، إذ أمسك به رجال الأمن، وأوسعوه ضربا، وكانت إصاباته بالغة السوء، بل أظنه كاد يقتل فى مدخل إحدى العمارات فى شارع قصر العينى.
حين بدأنا بالجرى، وجدنا أمامنا تشكيلات ضخمة جدا من شرطة مكافحة الشغب، وكان ذلك طبيعيا ومتوقعا، لأننا نسير فى اتجاه مبنى مجلس الشعب، لذلك لم نجد خيارا سوى أن ننحرف يسارا إلى ضاحية جاردن سيتى، لنصل بعد أن نعبرها إلى الكورنيش، ومنها إلى ميدان التحرير.
ولكن ما حدث، أن شرطة مكافحة الشغب حاصرتنا فى محطة للوقود، وتجمعنا عدة مئات، وأمامنا جيوش من الشرطة بهراواتهم السوداء يقفون مستعدين للفتك بنا.
مع بداية الحصار حاول بعض ضباط أمن الدولة بملابسهم المدنية أن يضربوا المتظاهرين، وفوجئوا بمقاومتنا الشديدة، أنا شخصيا ضربت أحدهم وهو يضرب أحد الشباب بعصا غليظة فى يده، إذ أخذت العصا منه وضربته بها، مما تسبب فى حالة من التجمد فى الموقف، فالشرطة لم تكن تصدق أن هناك من يجرؤ على مقاومتها بهذه البسالة، ونتج عن ذلك أن تمكن الشباب من الصعود إلى مبنى موجود فى المحطة، وظللت أنا وعدة أفراد واقفين أمام طابور الشرطة.
وفجأة، قفز رجل من العاملين فى المحطة محذرا الجميع من أننا نقف على خزان البنزين الرئيسى فى المحطة، وأننا جميعا فى خطر كبير!
كان ذلك مخرجا لنا، فجاء الفنان المصرى (عباس أبوالحسن) وتفاوض مع الضابط بشأن خروجنا، هو وأحد الأصدقاء الأعزاء (وهو من أقارب شخص مهم جدا فى النظام الحاكم)، ونجحت المفاوضات، وخرجنا من المحطة إلى ضاحية جاردن سيتى.
وعند خروجنا، حصل بينى وبين ضابط شاب احتكاك لا أدرى كيف بدأ، ولكننى أظن أن كتفى لمسه وأنا أسير خارجا، فما كان منه إلا أن دفعنى بقوة، فوقفت، ونظرت إليه فى عينيه، فسبنى بالأم!
حينها قلت له بكل أدب وغضب: هل تعرف أمى؟
فسبها مرة أخرى: فقلت له ما معناه إنك شخص تافه وأنا أقترب منه، وفى يده هراوة، ووقفت أمامه قائلا: لو كنت راجل... إضرب!

فوقف متسمرا وهو رافع عصاه، ويده ترتجف دون أن يتمكن من أن يضرب، وبعدها أتى عباس أبوالحسن، وصديقى الذى ذكرت، ومشينا.
أذكر هذه الحادثة الآن وكأنها إرهاصات الهزيمة النفسية لجهاز الشرطة، ذلك الجهاز الذى كان يعتمد على خوف الناس، وعلى تراجعهم أمامه، وحين تجرأ الناس انهارت كل أجهزة الشرطة فى وقت قياسى.
استغرقت رحلتنا إلى ميدان التحرير حوالى ساعة، وكانت محفوفة بالمخاطر، لأننا كنا تائهين فى ضاحية جاردن سيتى، وكنا نحاول أن نتجنب العديد من المصائب فى رحلتنا، أهمها مبنى السفارة الأمريكية، وكذلك السفارة الكندية، والبريطانية!
كنا خائفين أن نحتك بأى شكل من الأشكال مع الحراسات المخصصة لهذه الأماكن الحساسة.
وبفضل الله، وجدت ضمن المتظاهرين الدكتورة مديحة دوس، وهى من سكان جاردن سيتى فتمكنت من إرشادنا إلى كيفية الوصول إلى الكورنيش عبر متاهات جاردن سيتى، وسرنا حتى وصلنا إلى ميدان الشهداء (التحرير سابقا)، من أسفل كوبرى قصر النيل.
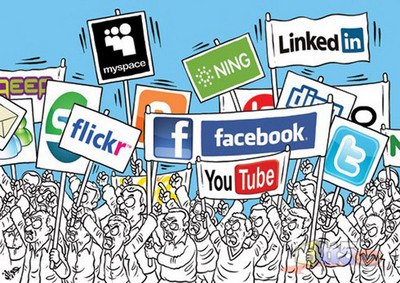
بالنسبة لى... كانت هذه اللحظة من أعمق لحظات عمرى!
لقد كان منظر الميدان وهو ممتلئ بعشرات الآلاف من المتظاهرين يبشر بالفجر الذى طال انتظاره، وحين دخلت الميدان ووجدت الشباب يهتفون فرحا بقدوم فوج جديد إليهم، ويستقبلوننى بالبشر والسرور.
حينها بكيت!
وبدأت أصرخ بشكل هستيرى: «مصر عظيمة، نحن شعب عظيم، أى كلب يقول إننا لا نثور سنضربه بالحذاء، ما أجمل مصر».
كل ذلك وأنا أبكى، وحولى مجموعة صغيرة من الشباب الذين اشتركوا معى فى هذه اللحظة الممتدة.
الميدان فى تلك اللحظة كان ملكا لنا، لا حركة سيارات، ولا شرطة مكافحة شغب فى داخله، الشرطة تقف على مداخل الميدان، دون أن تهاجمنا، أو بعد أن هاجمتنا وصددنا هجومها، وقد تم توثيق هروب الشرطة أمام المتظاهرين عبر كاميرات المحمول، ونشر ذلك على الفيس بوك، مما كان له أبلغ الأثر فى مظاهرات جمعة الغضب بعدها بأيام.
من أغرب ما حدث فى هذا اليوم، أننا حين وصلنا إلى الميدان، قرر العقل الجمعى للشعب المصرى العبقرى أن يحول الهتاف من (عيش.. حرية.. كرامة إنسانية)، إلى هتافات سياسية بحتة تطالب برحيل الرئيس، وسقوط النظام!
بعد أن تجمعنا فى الميدان بدأت المشاكل.
المشكلة الأولى: هى الاتصالات، فأصبح استخدام التليفون المحمول صعبا جدا، وذلك بسبب تشويش من عربات مخصصة لذلك يستخدمها جهاز أمن الدولة، مما صعب من تواصلنا مع بعضنا البعض كناشطين فى مناطق مختلفة، ولكن الخبر كان قد انتشر، وأصبح ميدان التحرير قبلة جميع المتظاهرين فى ذلك اليوم، فجاء المتظاهرون من المهندسين، ومن شبرا، ومن ناهيا ومناطق الجيزة المختلفة، وبعد العشاء اكتمل العدد، وقد وصل إلى ما أقدره بحوالى أربعين ألفا.
المشكلة الثانية: كانت فى كيفية التعامل مع كل هذه الحشود التى لا يربط بينها رابط، فأغلب الحاضرين كانوا من غير المسيسين، وكان الجميع لا يعرف ما الذى ينبغى عمله بعد ذلك! لذلك، كلفت الشباب بشراء سماعات وميكروفون فورا، وأخرجت من جيبى الخاص مبلغ ١٢٠٠ جنيه، وبالفعل ذهب (محمود عادل) الناشط المعروف ومؤسس جروب «البرادعى رئيسا» إلى باب اللوق واشترى سماعة ضخمة، وميكروفونا، مع عدة كهرباء.
عبد الرحمن يوسف



ساحة النقاش