قراءة في كتاب:
ملامح سردية في كتاب "ضاحية قرطاج"<!--[if !supportFootnotes]-->[1]
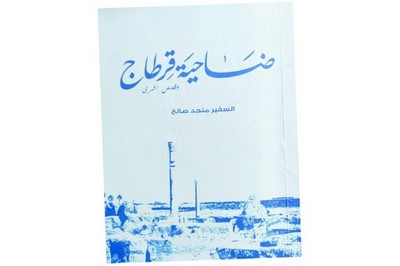
فراس حج محمد
ربما لا يندرج كتاب "ضاحية قرطاج وقصص أخرى" للكاتب الفلسطيني منجد صالح<!-- ضمن فن "القصة القصيرة" إلا في بعض من نصوصه، ليكوّن مجموعة قصصية تراعي النصوص السردية المحققة لشروط كتابة القصة القصيرة، تلك الشروط المتعارف عليها عند النقاد والكتّاب على حد سواء. وهنا أستحضر ما قاله يوسف زيدان بخصوص الرد على الناقد صلاح فضل عندما وجه ملاحظة لرواية زيدان "ظل الأفعى": "إن من يدخل مدينة الرواية عليه أن يحترم قوانينها"، فأجابه زيدان: "ما هي قوانين الرواية حتى نحسب قدر انحرافي عنها"، وكان الدكتور صلاح فضل قد كتب مقالا نقديا وصف فيه الرواية بأنها "تجربة فذة، فيها ما يطيح أحيانا بالتقنية الروائية"<!--. وهنا ربما من حق الكاتب منجد صالح أن يقول للناقد ما قاله زيدان للناقد صلاح فضل.
تحيل هذه المسألة إلى أصل نشأة الإبداع وفنونه وتقعيد هذه الفنون، فمن الثابت أن النصوص الإبداعية أسبق من النظريات النقدية، لقد كتب الكتاب أولا ثم جاء النقاد واستقرؤوا تلك النصوص ووضعوا القواعد النقدية، هذا ما فعله أرسطو مثلا في كتاب "فن الشعر" في دراسته للكوميديا والتراجيديا في زمنه أو في النصوص السابقة، وكما فعل النقاد العرب في اشتقاق علم النحو وعلم العروض ووضعوا قواعد للشعر، فجاءوا بنظرية عمود الشعر، وقواعد النحو وبحور الشعر. ولأن هذه القواعد استنباطية فهي ليس حتما لازما، فجاء كتاب كبار وانتهكوها سواء في المسرح في الخروج على قواعد أرسطو أو في الشعر والخروج على قواعد الخليل بن أحمد أو قواعد المرزوقي في توصيفه لعمود الشعر. بل إنني أقول: إذا ظل الكتاب أسرى القواعد النقدية، فإنهم لن يكتبوا إبداعا حقيقيا. فالحرية بمعناها الأشمل الفكرية والإبداعية والانطلاق الحر في الكتابة هي السبب الوحيد في ولادة نصوص مميزة وخالدة.
وبعيدا عن إخضاع هذه المجموعة لمنطق القصة القصيرة، فإنه لجدير بالكاتب والناقد معا أن يقولا إنه لا يوجد قواعد مقدسة للكتابة، بل إن كل كتاب يخلق قواعده من ذاته، ومن رؤى كاتبه وثقافته ولغته ورسائله التي يريد إيصالها للكاتب. وعليه، فإنه لمن المهم التغاضي عن ذلك الخروج على تلك القواعد المقررة في كتابة القصة القصيرة، والبحث عن ملامح تلك البنية اللغوية التي سعى الكاتب بقصد أو من دون قصد للخروج على تلك القواعد، في البنية والحدث والزمن والعقدة وما سوى ذلك، وإن حافظت كل قصة على أهم ما يميز القصة القصيرة وأقصد بذلك "وحدة الانطباع"، كما تكشف هذه النصوص قدرة الكاتب على السرد والاهتمام بالتفاصيل، كأنه يستخدم آلة تصوير بمميزات عالية الوضوح.
إن كل عمل أدبي له ميزة خاصة، يجب أن يتحلى بها، ليشكل حضوره إضافى فنية في سياق الأدب الذي ينتمي إليه، فما الذي يميز كتاب "ضاحية قرطاج" من سمات سردية وفنية؟
عليّ أن أشير أولا إلى ملحوظة مهمة في هذه السرديات الإحدى عشرة، وهي أن كل واحدة منها ذات نمط خاص وأسلوب يميزها عن غيرها، فلا تتشابه قصتان من هذه القصص، وإن نهلت كل القصص من مَعين "الواقعية"، فكل تلك النصوص تنهل مادتها من الواقع المعيش، لتقدم جانبا مهما منه، في النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية، وكان يحرص الكاتب دائما على أن يزود القارئ بمعلومات ثقافية، وهو يتحدث عن تاريخ فلسطين والدول التي قد تشكل القصص محورا من محاورها، أو حتى إن مرت عرضا في سياق القصة، ليترك الكاتب الحدث الرئيسي ويأخذ في الاستطراد، فيقدم معلومات قيمة حول هذه القضية أو تلك، وبالتالي شكل هذا الكتاب مصدرا من مصادر المعلومات التي تغني ثقافة القارئ.
لقد أتاح هذا التنوع الذي بنيت عليه النصوص لأن يقدم الكاتب للقارئ مجمل آرائه وثقافته، فكشف الكتاب عن مصادر ثقافة الكاتب وتنوعها، وعن استفادته من القصص العربية القديمة التراثية والشعر العربي والتاريخ العربي والتراث العالمي السياسي والثقافي.
يوظف الكاتب، وبشكل لافت، الحكايات والأمثال الشعبية واللغة العامية الفلسطينية، فقد زخرت تلك القصص بالتعابير الشعبية الدارجة والأمثال التي يوردها، وقد شكل هذا الجانب ملمحا فنيا عميق الدلالة على أهمية تلك القصص، فغدا الكتاب حاضنا فنيا للغة الشعبية والمزاج اللغوي للناس، وهو ينقل أحاديثهم وحواراتهم في الزواج وفي لعب "المحبوسة" وفي المعاناة على الحواجز، وغيرها.
يعد الاهتمام بالثقافة واللغة الشعبية في سياق الأدب الفصيح، وفي مدونة الأدب الفلسطيني خاصة، أمرا ذا دلالة مهمة في ارتفاع هذه النصوص إلى مرتبة المقاومة باللغة، فالشعب الفلسطيني شعب حي، له تاريخ، ولغة، وثقافة خاصة شعبية، صنعتها الأجيال عبر التاريخ، عصية على المحو والإلغاء، فالثقافة بكل تنوعاتها ومن بينها اللغة بشتى ألوانها الأدبية هي دلالة على وجود هذا الشعب وتجذره، فهو ليس طارئا أو عابرا، إذ تقف هذه النصوص كائنات حية تحفظ هذه اللغة من الاندثار، وتقاوم المحتل وأساليبه في محو التاريخ واللغة، كما يتعمد محو ملامح الجغرافيا، لقد شكل الصراع على اللغة في فلسطين جانبا مهما من الصراع السياسي والثقافي، فالأسرلة لم تطل المدن والتراث بل طالت أيضا اللغة، وإحلال لغة محل أخرى. فاللغة لم تكن في يوم من الأيام وسيلة تخاطب فقط، بل إنها ذاكرة حية للشعب والأمة، ومن هنا ندرك أهمية المحافظة على هذه اللغة الخاصة، وندرك أيضا توجه المحتل، أي محتلّ، في كل بقعة من العالم إلى استهداف لغة المستعمَرين ومحوها، والشواهد كثيرة، ليس في فلسطين وحدها، فقد حدث هذا في أوطان عربية كثيرة وفي دول العالم المحتلة أيضا.
إن الحديث عن هذا الجانب كبير ومتعدد، ويحتاج إلى وقفة مستقلة، ولكنني أود الإشارة إلى تنبه الكاتب إلى هذا الصراع اللغوي في فلسطين بين لغتين، عربية أصيلة وعبرية طارئة، مع أن الكاتب يذكّر القارئ أن اللغة العبرية ما هي إلا لغة سامية وتشترك مع العربية بمميزات ومفردات كثيرة، ولكن إبراز هذه اللغة كلغة احتلال وإحلال كان دافعا قويا لمقاومة وجودها. يصف الكاتب اللغة العبرية بأنها "لغة سهلة على الناطقين بلغة الضاد، اللغة العربية. مفرداتها وتعابيرها مشابهة للغة العربية"، ويضيف موضحا: "يخال للمرء أن العبرية ما هي إلا مولود صغير ولد بعملية قيصرية من رحم اللغة العربية الأم"، ويتعدى الحديث عن اللغتين وأواصر العلاقة بينهما إلى ما بين العرب واليهود من أصل مشترك، "فالعرب ساميون مئة بالمئة. وكذلك اليهود"<!--.
إذاً، المشكلة على ما يبدو هو إدخال اللغة التوأم إلى سياق احتلالي صهيوني، يحتل الجغرافيا والتاريخ ويعمل على إلغاء الطرف المقابل المحتل، وعمل على سلخ اللغة العبرية من تاريخها السامي، وبذلك أصبحت اللغة العبرية بفعل النظرة الاستعمارية لغة معادية تنافس في وجودها اللغة العربية، وقد حققت إسرائيل ذلك بسنها "قانون القومية" الذي لم يستثن اللغة العربية من هذا القانون، وكذلك قانون منع الأذان. وقد عبر محتجون على القانون آنذاك في العريضة المرفوعة للكنيست الإسرائيلي عن هذا الهدف بقولهم: "إن القانون لا يسعى إلى "جودة حياة" كما يحاول المبادرون إلى القانون القول، ولا حرية العبادة بل هو قانون لإسكات صوت المؤذن ومحاولة فاضحة لإسكات العربية وشطبها من الحيّز العام"<!--.
ومن الملامح الظاهرة في نصوص الكتاب أيضا سوى الثقافة الشعبية، وحضور مفرداتها وحكاياتها وأغانيها وأمثالها، اعتماد الكاتب على السخرية والفكاهة. فقد اشتملت كثير من النصوص على مقاطع ساخرة أو فكاهية متعددة ضمن سياقها الاجتماعي أو السياسي، وتطال السخرية والفكاهة كثيرا من المواقف في تلك النصوص، ومن ذلك ما جاء في قصة "الجدي الأبرق"، عدا ما في العنوان من فكاهة شعبية معروفة، فقد اعتمدت القصة في كثير من مقاطعها على الفكاهة الشعبية اللطيفة، فمسعود الذي يحلم بالذهاب إلى أمريكا يريد أن يعلّم الأمريكان "شرب الأرجيلة، وتحضير أنواع جديدة من "المعسّل"، ويريد إدخالها إلى اللغة الإنجليزية "حتى نقول إننا نحن أيضا نؤثر في حياة الأمريكان وفي لغتهم وثقافتهم، بأنواع متعددة ونكهات متعددة من المعسل الطازج الأصلي"<!--.
كما تجنح اللغة أيضا إلى اعتمادها على الترادف، فيحشد مفردات متعددة في سياق واحد، ليخلق اجتماعها مزيجا لغويا فَكِهاً، كما في هذا المقطع: "كانت أولوية المساعد الثالث الأولى والثانية والثالثة والهامة والمهمة والضرورية والقصوى والمطلقة والمفضلة "والتي لا يوجد منها اثنتان" هي رغبته الأكيدة في أن يوافق الحاجب على اقتراحه وترشيحه للمندوب أو المبعوث إلى إمبراطورية الصين"<!--. إن ما يُلاحظ على هذا المقطع خلوه من أية علامة للترقيم، فالكاتب لا يريد للقارئ أن يلتقط أنفاسه؛ ليحقق رغبته في إحداث ما يريد من السخرية التي جسدتها اللغة بالمفردات المتتابعة دون أية وقفات، هي لازمة في غير هذا الموقع، ويخيل إليّ أن الكاتب لو وضع علامات الترقيم لذهب كثير من مراده وهدفه في تحقيق اللغة الساخرة، وكذلك فعل في موضع آخر من النص، كما في الصفحة 114. كما أنه أيضا يحقق الفكاهة في بناء النص بجمل مسجوعة متتابعة، كما جاء في القصة نفسها في الصفحة (125-126).
ومن الأساليب الفكاهية في القصة كذلك ما جاء من سخرية مشهدية، في تصويره للإنسان الذي يأكل طبق ال "سيفيتش" البيروفي "هنيئا مريئا، ولكن والدموع في عينيه، ومنديل من الورق أو القماش طوال الوقت يجفف به أنفه الذي يسيل منه سائل بسبب كون الطبق الشهي حارا، وحارا جدا"<!--. ويعيد الكاتب هذه التقنية في رسم مشهد فكاهي آخر في الصفحة (120-121).
ومن أكثر المقاطع فكاهية ما جاء في نهاية قصة "ماريا وعبد الرحيم"، حيث يكتب لعبد الرحيم أحد أصدقائه رسالة يخبره فيها عما فعلته ماريا في غيابه<!--، فقد صاغ الكاتب تلك الرسالة معتمدا على المفارقة الساخرة ذات اللغة التراثية، ولا يحسن بي أن أقتبس منها أي مقطع، لأن ما فيها من فكاهة لا يتحقق إلا بقراءتها جميعا دفعة واحدة.
لم تكن كل تلك التقنيات اللغوية والسردية التي يوظفها الكاتب في نصوصه خالية من الدروس الأخلاقية، فالكاتب يكتب قصصا واقعية، ولم تكن واقعية فقط بل كانت في جزء منها حقيقية، فقصة "الصديق المكافح" لم تكن سوى سيرة غيرية أو مقالة عن صديقه الباحث والمترجم عليان محمد الهندي، كما استفاد من أدب الرحلات، والرمزية الاستعارية، كما في قصة "الطائر العجيب"، كما تناول هموم الناس ومعاناتهم الاجتماعية في صراعهم مع الحياة والفقر، وجانبا من معاناة الشباب المكافحين من أجل العيش أو الدراسة أو العمل. إن هذه الواقعية جعلت الكاتب أسير حرْفية الواقع ولم يجنح إلى التلاعب الفني بالحكايات لتكون مفاجئة على نحو يُحدث الدهشة لديه، فمن أجل هاتين الوظيفتين الدرس الأخلاقي والواقعية لم يلتزم الكاتب بشروط الفن القصصي، وربما وقعت بعض نصوصه بتناقضات تخل بشروط الفن وصنعته، ولعل هذا واضح في قصة "اللص ابن أبيه"، وقصة "حازم الحازم"، وقصة "ضاحية قرطاج"، فقد نسي الكاتب أو تناسى الملف بُنيّ اللون الداكن، فلم يتبين مصيره وأين ذهب، وربما لم يكن سوى حيلة للحديث عن فلسطين في حقبة الستينيات.
لقد ضحّى الكاتب بمادة كان يمكن لها أن تشكل مادة سردية بحبكة قصصية فنية من أجل الدرس الأخلاقي والواقعية المفرطة في التزامها بمادة الواقع التي تعيش خارج سياق النص. ولعل هذه الواقعية ذاتها هي التي جعلت كتاب "ضاحية قرطاج" كتاب حكايات الناس وقصصهم، فقد التزم فيها الكاتب السرد على نمط الراوي الشعبي للحكايات الشعبية أو القصاصين العرب، وانعكس ذلك على اللغة بحيث كانت في مجملها بسيطة، أدت هدف الكتاب ورسالته.

<!--[endif]-->
<!-- ألقيت هذه المداخلة في حفل توقيع الكتاب في نابلس بتاريخ 22-9-2019، وصدر الكتاب عن مؤسسة سيدة الأرض، ويقع في (203) صفحات من القطع المتوسط.
<!-- كاتب فلسطيني متقاعد من السلك الدبلوماسي، حيث عمل في سفارة فلسطين في تونس، وعمل سفيرا لفلسطين في المكسيك، يكتب القصة القصيرة والمقال السياسي الساخر.
<!-- برنامج: مقابلة خاصة على الفضائية المغربية أجرتها المذيعة المغربية غادة الصنهاجي، يمكن الاطلاع على المقابلة خلال الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=WCtT800-GuQ
<!-- ضاحية قرطاج وقصص أخرى، (ص77).
<!-- موقع بانيت، عريضة باللغة العبرية ضد قانون منع رفع الأذان: https://www.panet.co.il/article/1535765، نشر في الموقع بتاريخ 15-11-2016.
<!-- ضاحية قرطاج، (ص37).
<!-- السابق، (ص111).
<!-- السابق، (ص116-117).
<!-- يُنظر الرسالة في القصة الأخيرة من كتاب "ضاحية قرطاج"، (ص202).
______________
المقال منشورا في صحيفة الرأي الأردنية



